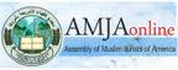كتب لصحيفة الوسط
الحمد لله
إن هذه الثورة المباركة قد غيرت الواقع المصري في أسابيع قليلة بما لا يقارن بشيء في الماضي الحديث، وينتظر منها المزيد. وهذا المنتظر لا يتصور أن يكون خيرًا محضًا، ولكن يرجى أن يكون خيره أغلب من شره، وسيكون بإذن الله كذلك بقدر ما نحسن قراءة المتغيرات المتسارعة وآثارها على الدعوة بشقيها الإيجابي والسلبي، وما أتيح لنا من قدرات على التعاطي معها، ومن ثم نبدأ التخطيط المستبصر والعمل الدؤوب للإسهام مع شركاء الوطن في تحقيق خيره.
إن سقوط الطغيان سيشكل فرصة وتحديًا. أما الفرصة، وهي الأكبر والأهم، فإن التدين في العموم ضرورة فطرية، ولا شك أن الدعوة إلى هذا الدين بالخصوص إنما هي دعوة إلى الحق المنزل من عند الله الذي لا تجد النفوس أنسها إلا في رحابه ولا تسكن إلا في جنابه، وإن أراد الله بالناس خيرًا وخلي بين هذه الدعوة وبينهم، فإنهم سيستجيبون لها أعظم استجابة، ولقد كان صلح الحديبية فتحًا مبينًا لضمانه حرية الدعوة بالجزيرة، حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا.
وأما التحديات فهي وإن تنوعت ستكون دون الفرص بلا شك، إن توافرت النوايا الصالحة والهمم العالية في المرحلة القادمة. بل يقلبها – إن شاء الله – مضاء العزيمة إلى فرص عظيمة. ومن هذه التحديات تحديات الحرية والغنى والانفتاح.
تحدي الحرية
إن سقوط الطغيان الذي لا يختلف على الفرح به عاقلان هو نفسه يمثل تحديًا للدعوة. فمن الذي قال إن الناس يسقطون في اختبار الضراء فقط، بل سقوطهم في اختبار السراء أكثر. ولكن كيف يكون سقوط الطغيان تحديًا؟ أولاً: إن مما سيحدثه ذلك السقوط من تغيير أنه سيفقد الدعاة ذلك التعاطف الفطري مع المضطهدين، والذي استحقوه بامتياز في الحقب الماضية.
ولأن شعور الناس بالقهر يرجى أن يزول أو يخف، فلن يراهم أكثر الناس كالمخَلِّصين لهم من طغيان النظم الجائرة والمذَكِّرين لهم بالعدالة العمرية. بل إنه من صارت له منهم أية مساحة من التمكين سيطالب بتلك العمرية ذاتها التي كان يتحدث عنها، ولعمري إن القول والفعل يختلفان، والسعيد من وفقه الله.
ولن يكون الطغاة الحاجز بيننا وبين كل مراداتنا، كتحقيق النهضة مثلاً، والتي سيظهر الكفاح من أجل تحقيقها السلبيات الضخمة في مجتمعاتنا والتي جرتنا بداية إلى ما نحن فيه. سيبقى التحدي ماثلا ولكنه لن يختزل في ذهاب الطغاة، بل سيكون في تغيير مفاهيم وسلوكيات مجتمع بأكمله.
أما مرادنا من تحقيق العزة لأمتنا ورفع المظالم عنها وتحرير فلسطين، الخ، فإن الطغاة كذلك لن يكونوا الحاجز بيننا وبين ما نرجوه، ولكن تبقى حسابات القوة هي الحكم، فيغيب جزئيًا الدور البارز للقضية الفلسطينية في تجييش المشاعر وصناعة الصحوة.
وبسقوط الطغيان وفي مناخ الحرية المأمول، سيسقط عذر بعض الحركات الإسلامية بخصوص عجزها عن استقطاب شرائح أوسع من النخب. ذلك العذر الذي كان يستمد وجاهته من انحياز النخب إلى الطغاة وخوفها على مكتسباتها، فتلك النخب ستكون لها الآن مساحة أوسع من الخيار. والإسلام، وإن كان أكثر أتباعه من الفقراء والمستضعفين كما هو حال أتباع الحق في كل وقت، إلا أنه يسعى لجذب النخب التي يعول عليها في النهضة؛ وما كان العشرة المبشرون، بما فيهم الخلفاء الأربعة، إلا من النخبة في مجتمعهم. أنا لا أقول بأن النخب ليست مسلمة، ولكن المراد هو المزيد من تسليمنا وإياها لخالقنا وانحيازنا لمنهج الإسلام وإيماننا بشموليته وتبنينا لنظرته.
تحدي السراء
إن النهضة الاقتصادية المتوقعة لبلادنا يرجى أن ترفع الفقر عن كواهل كثيرين، والفقر بغيض، والمال سماه الله خيرًا، ولكن الغنى، وهو متوقع حصوله لشرائح أوسع من المجتمع، أيضًا له تحدياته، فهو مجبنة ومحزنة من جهة إذ يخشى صاحبه من ضياعه وهو ملهاة من جهة، مما يستدعي أن يكون في الدعوة من الجذب والترغيب ما يفوق ذلك.
كما أن انحسار الفقر ينبغي أن يغير من طبيعة الخطاب الذي يدندن حول تضميد جروح الفقر ومعالجة مشاعر الفقراء بالمبالغة في تحقير الدنيا ومتاعها والتشويق إلى نعيم الآخرة، بينما الإسلام يحض إلى طلب الحسنى فيهما معا ويعد بالحياة الطيبة فيهما معا.
تحدي الانفتاح
إن الحكومات القادمة يتوقع أن تسعى إلى نهضة اقتصادية تأخذ بالنماذج الصينية والهندية والماليزية والتركية والبرازيلية، والتي وإن اختلفت في بعض تفاصيلها، فإنها تشترك في أنها لم تصارع الأمواج بل ركبتها، فهي سعت إلى الاستفادة من كل إيجابيات العولمة والشركات العابرة للحدود، مع التقليل بقدر الإمكان من مضارها. إن هذا الواقع الجديد سيأتي بتحديات جديدة، فكثير من المصريين سيعملون في تلك الشركات ويخالطون الأجانب داخل مصر وخارجها في سفرات لحضور دورات أو مؤتمرات أو للتدريب…الخ. هذا الأمر ليس جديدًا، وهو واقع بالفعل، ولكن حجمه سيختلف.
إن مستخدمي الإنترنت قد تضاعفوا بعد الثورة، وهذا يعني أن شريحة أوسع من المصريين ستخالط في هذا العالم الافتراضي الشاسع أقوامًا شتى مختلفةً أديانهم وأعراقهم، مما يعني ورود شُبَه وأحوال عليهم لا عهد لهم بها من قبل، بل ومن تحديات هذا العالم الافتراضي أنه يوفر فضاءات مغايرة للتواصل الاجتماعي مما يؤدي إلى انحسار دور الضغط الاجتماعي التقليدي في حماية الدين أو المفاهيم السائدة عنه في المجتمع المحلي خطأً كانت أو صوابًا.
إن المأمول أن يشعر المصريون كافة بعد الثورة بالاحترام والتقدير المكفول لأقرانهم في البلدان الأخرى، وإن الثقافة العالمية المعاصرة التي تمجد الفرد وتدندن حول حقوقه لا ينبغي أن تقابل بخطاب استعلائي من أحد الدعاة عن الرعاع أو الغوغاء، فإن الله قد كرم بني آدم، ورسوله كان أحسن معلم وأحلم معلم وأرفق معلم، والسلف كانوا ينتقون أطايب الكلام كما يُنتقى أطايب الثمر. والإسلام كفل للناس من الحقوق والكرامة ما سنبقى ما بقي لنا عمر نسعى في تحصيل بعضه. إنه لا يشك أحد أن الناس فيهم غوغاء ورعاع، ولكن ما المقصود بهم وما هو المقام المناسب لذكرهم؟ هذا ما ينبغي تحريره حتى لا ينسب إلى العلماء ما هم منه براء.
أرجو ألا يفهم أنني أعيب على الدعاة المستبصرين شيئًا من استثمارهم السديد لعناصر المشهد المصري السابقة، فإن هذا لا يعاب إلا إذا انطوى على مغالطة أو كان لتحقيق مآرب شخصية ضيقة. والمخلصون من الدعاة المستبصرين مبرؤون منهما في الجملة، وإن كان الغلط دون المغالطة واردًا. إن الدعوات سواء كانت إلى حق أو إلى باطل تستعمل ما بين أيديها من معطيات لتصل إلى قلوب وعقول المخاطبين بها، وهذا ليس عيبًا إلا إذا كانت النوايا مدخولة أو العمل فاسدًا. كثيرًا ما أعيب على من ينتقد الدعاة إلى المسيحية في إفريقيا لمجرد أنهم يجندون ثرواتهم الضخمة في سبيل ذلك. أوليس هذا معنى سهم المؤلفة قلوبهم في الإسلام؟ ألم يعط رسول الله منه قومًا من الكفار رجاء إسلامهم؟ ونحن مع كوننا لا نبرئ كل المنصرين من استخدام وسائل ابتزاز ذميمة أو العمل من أجل أجندات إمبريالية لبلدانهم، فلا ينبغي لنا – ونحن أمة “ومن أهل الكتاب” – أن نتهمهم كلهم بذلك. فمن سلموا من التهمة، فلا يعاب عليهم إنفاق أموالهم في التمكين لدعوتهم من حيث المبدأ. كذلك، فإن استثمار رقة قلب الإنسان حال مرضه ودعوته بالحكمة لا ينبغي أن يعاب، فالهداية هي الخير الأعظم الذي نحب لكل أحد أن يشاركنا فيه. وقس على ذلك استثمار كل ما يعرض للبشر من أحوال في دعوتهم إلى الخير.
وفي مجموعة المقالات القادمة سأجتهد إن شاء الله – منتفعًا بتعليقات القراء – في طرح عدد من التحديات المتوقعة، والتي ذكرت بعضها أعلاه، وبيان ما أعتقده من حلول نافعة لمواجهتها.
ولكن قبل أن نبين تلك المتغيرات، وآثارها المحتملة، والأساليب المقترحة للتعامل معها، دعوني أبدأ بتوضيح المقصود من العنوان أو بالأخص المقصود من تجديد الخطاب الدعوي.
ربما يكون القارئ قد وقف على الجدال الحاصل في قضية تجديد الخطاب الديني، وهو غير ما نحن بصدده، وإن كان له به تعلق. وليس توضيحي ذلك للتبرؤ من هذا المصطلح، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “إنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الامة على رَأْسِ كل مِائَةِ سَنَةٍ من يُجَدِّدُ لها دِينَهَا.”[1] فذكر تجديد الدين نفسه، وليس الخطاب الديني أعم من الدين، فإما أنه الدين أو جزء منه، وفي الحالتين لا ينكر على من قال بالتجديد، كون القائل الأول بهذا المعنى هو رسول الله، ولكن يكون النقاش عن ماهية التجديد المقصود. بعض الناس قد يعترض بأن مقصود كثيرين ممن يرفعون شعار تجديد الخطاب الديني هو هدم الدين وإعادة صياغته بما يتفق مع أهوائهم، وهذا صحيح. لكن، مع تحريفهم للمعاني في الحالتين، أليست عبارة “تجديد الدين” التي نطق بنحوها الرسول – صلى الله عليه وسلم – أسعف لهم في تحقيق مرادهم؟ وإن قال البعض بأن لتجديد الدين مفهومًا حدده أهل العلم، يجاب بأننا سنستصحب هذا المفهوم على تجديد الخطاب الذي لا يعدو أن يكون بعض الدين أو كله.
أما ما نحن بصدده أصالة، فهو تجديد الخطاب الدعوي، والخطاب في اللغة هو المحاورة والمحادثة واستعمله الأصوليون، كما في خطاب الله للمكلفين بالأحكام. وللخطاب تعريفات فلسفية، فهو عند القوم، كما يبرز في كتاب نظام الخطاب لميشيل فوكو[2]، يعني نظامًا متكاملا في أحد المجالات المعرفية بمصطلحاته ومضامينه وأقسامه وأسسه وأهدافه…الخ أما الدعوة فهي في الاصطلاح دعوة الناس إلى العبودية الكاملة لربهم بما في ذلك الالتزام بشرعه تعالى. ولذلك فلا شك أن هناك قدرًا من التواطؤ بين الدعوة والدين والخطاب الدعوي والديني، فإن للدعوة قوالب وأساليب ومضامين، ومضامينها لا تعدو أن تكون الدين نفسه. وسيكون كلامنا عن المضامين مقتضبًا، ولذلك نبدأ به ثم نبسط الكلام في المقالات القادمة إن شاء الله عن قوالب وأساليب الدعوة وأخلاق الدعاة.
إذا كان تجديد مضامين الدعوة أو الخطاب الدعوي هو تجديد الدين أو الخطاب الديني، فما المقصود من ذلك باختصار؟
الأصل أن الدين لا تغير فيه، وأكثر التجديد المقصود هو تجديد إحياء أو تنقية، والأول بمعنى إحياء ما انطمس واندرس من السنن ونشرها بين الناس والثاني بمعنى تنقية الدين من البدع والمحدثات ومما علق به من أعراف الناس المخالفة للوحي. ولكن هناك نوع آخر من التجديد، وهو التجديد الاجتهادي، ومن أمثلته: منع أمير المؤمنين عمر المؤلفةَ قلوبهم من سهمهم، لما رأى عزة الدين وتمكين الله للمسلمين زمن خلافته المباركة، وأمر أمير المؤمنين عثمان بالتقاط ضالة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها، وكان الأصل النهي عن التقاطِها، وذلك لما رأى فساد الذمم. وكان العمل مستقرا عند أكثر السلف على تحريم تعاطي الأجر على تعليم القرآن، ثم أذن فيه لما قل المتطوعون خوفًا من ضياع القرآن.
ولكن هل غير هؤلاء الأكابر الحكم الشرعي؟ كلا فحكم الله لا يتغير ألم يقل تعالى: “اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ” [التوبة:31] وبيَّن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعَدِيِّ بن حاتم – رضي الله عنه – أن ذلك كان باتباعهم إياهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال.[3] ثم ألا يكون ذلك عين ما نهى عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: «من أحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما ليس مِنْه فَهُو رَدٌّ»[4]
إذًا يمتنع أن يكونوا غيروا حكم الله، وإن استعمل بعض العلماء هذا المصطلح، فإنما عنوا الفتوى لا الحكم الشرعي. إن العمل الواحد قد يكون له حكمان بحسب ما يكتنفه من أحوال مختلفة. ولتوضيح ذلك، نأخذ كمثال أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والتي كان المنع منها موضع اتفاق الأحناف المتقدمين ثم أذن فيها المتأخرون، والسؤال، هل جرى المنع والإذن على شيء واحد؟ إنه ليبدو كذلك، ولكن مع التدقيق يظهر أنه لا يصح أن يسوى بين أخذ الأجرة على تعليم القرآن في زمان توافرت فيه الهمم على فعل ذلك قربة، وحصل المعلمون كفايتهم من بيت المال، وأخذها في زمان ليس للمعلمين فيه أرزاق تجري عليهم من بيت المال، فإن هم انصرفوا للتعليم ضاع عيالهم، وإن انصرفوا إلى تحصيل الرزق ضاع تلاميذهم.
فالحاصل أن الواقع المعين قد تناسبه أحكام مختلفة من وجوه، فيختار المجتهد أنسبها له. وقد يتنازعه أصلان أو حكمان فيلحقه الحاكم بأقربهما إليه في المعنى والمبنى، وإن كان اعتبار المعنى مقدمًا عند التعارض استحسانًا. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي – رحمه الله: «إن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فُرِض بقاء الدنيا إلى ما لانهاية، والتكليف كذلك، لم يُحتَج في الشرع إلى مزيد. ومعنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم بها…»[v]فالأصلان في مثال أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن هما: الأول تجريد النية لله في القربات الذي رجح الحظر في الزمان الأول والثاني حفظ القرآن بتعليم الصغار إياه الذي رجح الإباحة في الزمان الثاني.
بقي أن هذا النوع من التجديد الاجتهادي، والذي لا يشمل أبواب العبادات ولا المقدرات في الشريعة كالحدود والكفارات، لا يصلح له إلا أفذاذ المجتهدين من العلماء في كل عصر، ولو ترك لغيرهم ممن هو دون رتبة الاجتهاد المطلق، لصار الدين في خطر وتعرض للتحريف. ولا نحتاج إلى ذكر جرم من فعل ذلك من غير العلماء أصلا، فإنه الطامة الكبرى وهو افتراء على الله – عز وجل – وقول عليه بغير علم. قال الله: “وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً”[الإسراء:36]
في المقالات القادمة نعرض إن شاء الله بشيء من التفصيل إلى التحديات التي يتوقع أن تعترض سبيل الدعوة في المرحلة القادمة وسبل مواجهتها فيما يخص قوالب وأساليب الدعوة وأخلاق الدعاة. وليس تعرضي لهذا المقام إلا من باب النصيحة الواجبة على كل مسلم، وقد يستفيد ببعض ما فيها بعض طلبة العلم، ولو قرأها أحد مشايخنا من الدعاة، لربما استلطف منها حسن جمع أو تقسيم أو ترتيب – إن كان ثمة – ولربما وقع على لطيفة أوردتها من كلام بعض أهل العلم مما قد يكون غاب عن بعضهم. وصلى الله على القائل “فرٌبَّ حَامِلِ فِقهٍ إلى مَن هُو أفقَهُ مِنه” وعلى آله وصحبه وسلم.
[1] أخرجه ابو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه. «سنن أبي داود دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» (4/109).
[2] «نظام الخطاب» ميشيل فوكو، ترجمة م. سبيلا دار التنوير، بيروت، 1986.
[3] «سنن البيهقي الكبرى، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 1414 هـ » كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي (10/116).
[4] «صحيح البخاري، بيروت: دار ابن كثير واليمامة، 1407 هـ. – الثالثة» كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (2/959)، «صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي» كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات (3/1343).
[v] «المُوافقات للشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز. – بيروت: دار المعرفة.» (2/217)