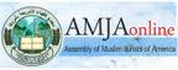إماء الله في بيوت الله
من نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام
بحث مقدم إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
التمهيد: منزلة المساجد وأهمية عمارتها 4
المطلب الأول: حاجة المرأة المسلمة للمسجد في الغرب وحكم إتيانها له. 6
المطلب الثاني: صفوف النساء والحائل بينهن وبين الرجال. 15
الفرع الثاني: مشروعية الحائل. 18
فصل: في حكم الزيادة على المسجد 30
المقدمة
بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن ربه فأتم البلاغ، وبين لنا شرائع ديننا في شتى مناحي الحياة، حتى غبطنا على بيانه أهل الكتاب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد،
فإن المسجد للجاليات المسلمة في بلاد الغرب هو بمثابة سفينة نوح عليه وعلى نبينا السلام؛ من اعتصم به نجا، ومن هجره خشينا عليه سوء العاقبة. وللمرأة المسلمة بالغرب حاجة بالمسجد تفوق حاجة نظيرتها بالشرق. وأنا أناقش في هذا البحث بعض أحكام المساجد المتعلقة بالمرأة المسلمة، وأجعل ذلك في ثلاثة مطالب: أولها عن حاجة المرأة للمسجد وحكم إتيانها إليه؛ وثانيها عن صفوف النساء ووضع حائل بينهن وبين الرجال؛ وثالثها عن المرأة الحائض وحكم مرورها بالمسجد ومكثها فيه وكذلك مكثها في بعض المرافق الملحقة به. وأجعل بين يدي ذلك تمهيدًا مختصرًا عن منزلة المساجد وأهمية عمارتها. ولقد ضمنت البحث في آخره مشروع قرار مجمعي.
التمهيد: منزلة المساجد وأهمية عمارتها
للمساجد في دين الإسلام منزلة سامية رفيعة حتى قال رسول الله r: “خَيْرُ البِقَاعِ المَسَاجِدُ وشَرُّهَا الأَسْوَاقُ.”([1]) واصطفى الله لإقامتها أنبياءه؛ قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾([2]) وأمرهم بتطهيرها فقال: ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾([3]) وأثاب على بنائها بأجزل الثواب؛ وفي ذلك يقول رسول الله r: “من بَنَى لله مَسْجِدًا ولو كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى الله له بَيْتًا في الْجَنَّةِ.”([4]) وجعل الله بيوته موئل الصالحين من عباده ومهوى أفئدتهم؛ قال رسول الله r: “سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ الله في ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ … وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمَسَاجِدِ.”([5]) ويكفي عمارها قول ربهم: ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾([6])
وللمساجد دور رئيس في بناء المجتمع المسلم حتى ابتدأ رسول الله مهمته في المدينة ببناء المسجد الذي جعله في مركزها وجعل بيوت أزواجه حوله في إشارة لا تخفى إلى أهمية دور المسجد للدين والمجتمع وتنيه على مركزيته.
إن ما سبق ينطبق بطريق الأولى على المجتمعات الإسلامية الناشئة في الغرب وحيثما يكون المسلمون أقلية. إن المسلمين في هذه البلاد أو أكثرها متفرقون بين أهلها، وقد تمر على بعضهم الشهور من غير أن يرى أحدًا من أهل القبلة إلا أن يكون ذلك في المسجد. إن المساجد في هذه البلاد هي الصلة والجسر بين المسلمين ودينهم، فيها يقيمون صلاتهم ويتذاكرون كتاب ربهم ويتعلمون سنة نبيهم ويحفز بعضهم البعض إلى الذكر والدعاء؛ وفيها يتعارفون ويتآلفون فتقوى بذلك الوشائج بينهم ومن ثم بينهم وبين أمتهم؛ ولا جرم فإن هذا يقوي إيمانهم بالدين ويعمقه وينمي اتصالهم بالله ويوثقه. إن أهمية المسجد للناشئة من أبناء المسلمين تكمن أيضًا في الضرورة الماسة إلى أن تكون لهم بالإسلام صلة غير الأبوين الذين ربما يكونان أحيانًا سببًا في بعد هؤلاء عن الدين لا قربهم. وفي بعض الصالحين من عمار المساجد قد يجد الأولاد القدوة الحسنة التي افتقدوها في الآباء.
إنه من المهم أيضًا أن يكون للإسلام ورموزه وجود في عالم الحس لأن هذا يعزز الصلة بين الناشئة ودينهم، فإن حاجة الطفل واليافع إلى تجسيد المعاني أمر لا يخفى على العارفين، وهي فوق حاجة الكبار لذلك، وإن كان الجميع ينتفعون بالتلاقي بين عالم الفكر والمعقولات وعالم الحس والمشهودات.
المطلب الأول: حاجة المرأة المسلمة للمسجد في الغرب وحكم إتيانها له
“النِّسَاء شَقَائق الرِّجَال”([7]) وما يقال عن الرجل يقال عن المرأة حتى يثبت عكس ذلك. وأنا هنا لا أتكلم عن حكم الإتيان للمسجد فإن الفرق بينهما في ذلك لا خلاف فيه، ولكنني أعني أن ما قيل عن فائدة المسجد للفرد المسلم ينطبق على المرأة كذلك. وتزيد الحاجة في الغرب إلى تردد النساء على المساجد لأنهن في الأغلب من يحضر الأبناء إلى مدارس المساء أو العطلة أو لشهود بعض المناشط المخصصة لهم؛ ومن ثم فإن في تنفير المرأة المسلمة من المجيء إلى المساجد من الضرر ما لا ينبغي أن يغيب عن بصائر ذوي الحجا.
ولكن أهل العلم قد اختلفت آراؤهم بشأن السماح للنساء بإتيان المساجد، فذهب الجمهور إلى السماح لهن ولم يروا منعهن؛ وذهب البعض إلى عدم السماح لهن؛ وكره البعض مجيئهن ولم يمنعه؛ وفرق البعض بين الشواب والعجائز؛ وفرق آخرون بين بعض الصلوات وبعض، وهذه بعض أقوالهم:
قول السادة الحنفية:
قال الكاساني: “وأما النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين ؟ أجمعوا [في المذهب] على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة… وأما العجائز فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين, واختلفوا في الظهر والعصر والجمعة قال أبو حنيفة: لا يرخص لهن في ذلك وقال أبو يوسف ومحمد يرخص لهن في ذلك.”([8])
قول السادة المالكية:
وفي حكاية مذاهب العلماء قال ابن عبد البر: “وأما أقاويل الفقهاء فيه فقال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد فإذا جاء الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسًا أن تخرج كل امرأة متجالة. هذه رواية ابن القاسم عنه، وروى عنه أشهب قال تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد، ولا تكثر التردد وتخرج الشابة مرة بعد مرة …وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا … وقال الثوري أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. وقال ابن المبارك أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين. فإن أبت أن تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك…قال أبو عمر أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها.”([9])
قول السادة الشافعية:
وقال النووي في حكاية مذهب الشافعية: “أما الأحكام، فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات، وهن اللواتي يشتهين لجمالهن، فيكره حضورهن. هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور. وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن الخروج بحال. والصواب الأول…فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى، فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن…قال الشافعي في الأم: أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات.”([10])
قول السادة الحنابلة:
وقال البهوتي: ” ( وإن استأذنت امرأة إلى المسجد ليلا أو نهارا، كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تفلة، غير مزينة ولا مطيبة ) لقوله r: “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات” رواه أحمد وأبو داود ( إلا أن يخشى ) زوجها في خروجها إلى المسجد ( فتنة أو ضررا ) فيمنعها عنه درءا للمفسدة. ( وكذا أب مع ابنته ) إذا استأذنته في الخروج للمسجد كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررا ( وله ) أي الأب ( منعها من الانفراد ) عنه; لأنه لا يؤمن من دخول يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. قال أحمد والزوج أملك من الأب ( فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم ) لقيامهم مقامه استصحابا للحضانة.”([11]).
و مما يستدل به المانع لهن من الخروج والكاره لذلك:
الأمر بالقرار في البيوت. قال الكاساني: “أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة، لقوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ في بُيُوْتِكُنَّ ﴾ والأمر بالقرار نهي عن الانتقال”([12]).
قول رسول الله r: “صَلاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ من صَلاتِهَا في حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ من صَلاتِهَا في بَيْتِهَا.”([13])
قول أم المؤمنين عائشة ل: “لو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r رَأَى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.”([14])
أن المرأة عورة، وفي ذلك ينقل ابن عبد البر عن الثوري قوله: ” وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا؛ قال الثوري قال عبد الله “المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان.”([15]) وقال الثوري أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين.”([16])
سد الذريعة إلى الفتنة، وفي ذلك يقول الكاساني – رحمه الله -: “ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.”([17])
تغير أحوال الناس، وفي ذلك يقول ابن عبد البر: ” ويشهد له [أي قول ابن المبارك بالكراهة] قول عائشة لو أدرك رسول الله r ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد، ومع أحوال الناس اليوم، ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك.”([18]) وقال النووي: ” فإن قيل هذا [قولكم بكراهة حضور الشواب وذوات الهيئات للعيد والصلوات] مخالف لحديث أم عطية المذكور قلنا ثبت في الصحيحين عن عائشة ل قالت لو أدرك رسول الله r … ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول.”([19])
أما المبيح لترددهن على المسجد والمانع للولي من منعهن فدليله:
قوله r “لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.”([20])
وفهم الصحابة له أنه على الدوام، فعن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ r يقول: “لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إذا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قال فقال بِلالُ بن عبد اللَّهِ والله لَنَمْنَعُهُنَّ قال فَأَقْبَلَ عليه عبد اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا ما سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مثله قَطُّ وقال أُخْبِرُكَ عن رسول اللَّهِ r وَتَقُولُ والله لَنَمْنَعُهُنَّ.”([21])
ولقد ذكرت عاتكة زوج الفاروق أن عمر أراد لها عدم الخروج إلى المسجد فكانت تقول: “وَالله لأَخْرُجَنَّ إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَنِي فَلاَ يَمْنَعُهَا.”([22]) حتى ذكر في سيرته أنها كانت حاضرة بالمسجد في يوم قتله t. فانظر إلى عمر t يحب لزوجه عدم الخروج وهو من هو في حزمه وشدته وتمام مروءته وغيرته فلا يمنعه من منعها إلا أمر عظيم، وهو خوفه أن يخالف عن أمره r.
وإنما كان قول عائشة ل تحذيرًا للنساء من إحداثهن من الشر ما لم يكن معهودًا في أيامه r فإنها لم تمنعهن.
أمره بإخراج النساء إلى صلاة العيد فعن أم عطية ل قالت: “أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ …”([23])
وأجاب المانع على أدلة المخالف بما يأتي
أجابوا عن أمر الرسول بإخراجهن للعيد بأنه كان لتكثير سواد المسلمين في المدينة ([24]) وقد كان يساكنهم فيها غيرهم، قالوا: ومعلوم أن الحائض لا تصلي. وادعوا النسخ بحديث “صَلاة المَرْأَةِ في بَيْتِهَا” كما فعل الطحاوي في معاني الآثار.
والجواب على ذلك الجواب أن الحديث فيه سبب خروجهم “وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ” فلا وجه لإهمال العلة المنصوصة لأخرى مستنبطة. أما النسخ فلا يسلم لعدم ثبوت تقدم أحد الحديثين على الآخر، ولإمكان الجمع، ولسيرة الصحابة الثابتة في السماح للنساء بإتيان المساجد.
وأجابوا عن حديث لا تمنعوا إماء الله بحديث عائشة وبما سبق أعلاه.
أما منع النساء من المساجد فلا سبيل إليه وذلك:
لثبوت نهيه r الصريح، وعدم ثبوت النسخ وعمل الصحابة به وتشديدهم على المخالف.
وقاعدة سد الذرائع صحيحة، وإن تفاوت اعتبارها بين أهل العلم، ولكنها لا تقوى على معارضة صريح نهيه r. أما استعمال القاعدة لمنع المرء موليته أو زوجه من الخروج إلى المسجد في حال معينة فليس تغييرًا لعموم الحكم، وإنما هو من باب تحقيق المناط وتنازع أصلين لواقعة عين تلحق بأولاهما بها.
وتغير الزمان ليس يسوغ مخالفة مثل هذا النهي الصريح منه r. وفي القول بذلك، في تقديري، خطر على الدين والملة. نعم قد يسوغ تغير الحال شيئًا من تشديد الضوابط ومزيدًا من الاحتياط.
إن منع النساء من الخروج إلى المساجد للفتنة مع خروجهن للعمل – عند من أذن في ذلك – ولغير ذلك من قضاء الحوائج فيه ما فيه.
ولكن حيث قررنا أن احتمال الفتنة لا يكون مسوغًا لمنع المرأة من المساجد أو تنفيرها عنها، فلا بد من التأكيد على ضرورة الانتباه لخطر تلك الفتنة وعدم التهاون بها، فإن التساهل الذي يراه جميع المقيمين في الغرب في الاختلاط بين الذكور والنساء في أكثر المساجد يصل في أحيان كثيرة إلى ما تتقزز منه نفوس الصالحين وتقشعر أبدانهم.
إن حبس المرأة في البيت غير قرارها فيه، فالأول كان عقوبة لها قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ ([25])والثاني مكرمة ورفعة وأمره تعالى لخير النساء أمهات المؤمنين ولمن بعدهن من سائر نساء المسلمين. ولقد جاءت ترجمة المقصود بالقرار في البيوت في سيرتهن رضي الله عنهن.
لقد كان رسول الله r – وقد علم ما علم من غيرة أمته المحمودة على الأعراض – حريصًا ألا تكون هذه الغيرة سببًا في حرمان المرأة المسلمة من زيارة بيت ربها؛ فقال r: “لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.”([26]) وانظر إلى جمال تعبيره r “إماء الله” فلا ريب أن صاحب جوامع الكلم r أراد أن يشير بهذا التعبير إلى معان جليلة عظيمة، وينبه على حق الإماء الضعيفات المنكسرات ألا يمنعن من بيوت السيد الأعظم، والرب الأكرم، والمحبوب الأرحم؛ جل في علاه.
أما الأفضلية، فإن صلاة المرأة لذاتها وفي جوهرها ومتى كانت مجردة عما يحتف بها من أعراض وأمور أخرى، هي خير في بيتها منها في المسجد لصحة الخبر بذلك عن المعصوم. وحيث قررنا ذلك فإننا لا نرى أن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة اتفقن على ترك الفاضل للمفضول، ولكن إتيان المسجد لا يقتصر النفع منه على الصلاة بل ينضاف إلى ثوابها أجر سماع العلم وشهود الخير ودعاء المسلمين وغير ذلك من الفوائد. وقد يكون خروج المرأة للصلاة في المسجد، وسماع الذكر، مع اصطحاب ولدها ليتعلم ما ينفعه، أعظم أجرًا من بقائها في بيتها وصلاتها فيه.
إن حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت فيه فوائد جليلة، منها تشجيع المرأة على لزوم بيتها لحاجة أهلها وأولادها، وطمأنتها أنها ستدرك أجر الصلاة كاملا وإن كانت في قعر بيتها بخلاف الرجال الذين يحصل لهم من فوات الأجر العظيم عند التخلف عن الجماعة ما هو معروف، فما أرفق هذا الدين وما أكرم الله رب العالمين.
ضوابط خروج النساء للمساجد
وحيث قررنا عدم جواز منع النساء من المساجد في عموم الأحوال وأن خروجهن يكون أحيانًا أولى من بقائهن في البيوت، فإن ثمة ضوابط لا بد أن تلتزم حتى يتحصل المقصود من خروج النساء إلى المساجد مع اجتناب ما يمكن اجتنابه من الكدر والضرر الذي لا يكاد ينفك عن ذلك؛ منها:
عدم إكثار التردد على المساجد لغير حاجة. وفي حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت تنبيه للمرأة على عدم الإكثار من الخروج والدخول والذهاب والمجيء، فإنه لا يصلح لها أن تصلي خمسها في المسجد، فما الذي يبقى من قوله تعالى “وقَرْنَ” وأي بيوت تلك التي يترك فيها الأطفال خمس مرات في اليوم بلا راعٍ. إن تحذير العلماء كمالك من كثرة التردد مهم ومفيد ولا ينبغي أن يهمل أو يتجاوز.
أن يكون خروجهن بإذن الأولياء أو الأزواج، فإن منع الرجال من منع مولياتهم من المساجد ليس بحال إذنًا للنساء بترك الاستئذان.
الالتزام بالحجاب وعدم التزين. إن حديث “لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.”([27]) زاد فيه أبو داود “ولْيَخْرُجْنَ تَفِلات.”([28]) قال النووي: “أي غير متعطرات ولأنها إذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد.”([29])
ترك مخالطة الرجال في المساجد وخارجها:
فعن أم سَلَمَة ل قالت: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ”([30])
وروى أبو داود في (بَاب في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في الْمَسَاجِدِ عن الرِّجَالِ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.”([31])
وعن أبي هريرة قال : قال النبي r: “خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.”([32]) قال النووي في شرحه على مسلم: “وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم.”([33])
وقد روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه في (بَاب في مَشْيِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ في الطَّرِيقِ) عن أَبي أُسَيْدٍ الأنصاري أنه سمع رسول الله r يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ [تسِرْن وسطه] عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.”([34])
الاعتناء بستر العورات وغض البصر بين الرجال والنساء، فقد روى مسلم في (بَاب أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لا يَرْفَعْنَ رؤوسهن من السُّجُودِ حتى يَرْفَعَ الرِّجَالُ) عن سَهْل بن سعد قال لقد رأيت الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ في أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ من ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ النبي r فقال قَائِلٌ يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رؤوسكن حتى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.”([35]) وهذا في غض النساء أبصارهن عن عورات الرجال والأمر فيها أهون والخطب فيها أيسر.
أن تراعي المرأة الاحتشام في كلامها ولا تلين القول ولا ترفع الصوت عن الحاجة، فإن خفض المرأة لصوتها من حسن الأدب، وقد أشار إلى هذا المعنى رسول الله r حيث قال للرجال: “مالي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ من نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فإنه إذا سَبَّحَ الْتُفِتَ إليه وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.”([36]) إن هذا الأمر في الصلاة، وفيه إشارة إلى الفرق بين صوت المرأة والرجل، ولكنه لا يعني بحال أن المرأة لا تتكلم في المسجد، بل وتناقش وتراجع، فهذه المجادلة قد سمعها ربها من فوق سبع سماوات وهي تجادل خير خلقه وسيد الأئمة والعلماء فيما كان بينها وبين زوجها. إن بولس، الذي يسميه النصارى رسولا، قد أمر بأن تصمت النساء في الكنائس، ومحمد رسول الحق والهدى قد اتسع صدره لامرأة تجادله في المسجد، ثم نصرها ربها وأيد حجتها بآيات تتلى إلى انقضاء الدنيا.
أن تختار المرأة من المساجد ما تكون فيها أقرب إلى الستر والصيانة، وأبعد عن مواطن السوء والعطب.
المطلب الثاني: صفوف النساء والحائل بينهن وبين الرجال
الفرع الأول: صفوف النساء
لا شك أن الأصل أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فإن ذلك كان الشأن في مسجده r من غير خلاف.
وعن أنس “أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ r لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ منه ثُمَّ قال قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ قال أَنَسُ بن مَالِكٍ فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عليه رسول اللَّهِ r وَصَفَفْتُ أنا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ من وَرَائِنَا فَصَلَّى لنا رسول اللَّهِ r رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.”([37])
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله r: “خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.”([38])
هل يجوز للنساء الوقوف على ميمنة الرجال أو ميسرتهم أو أمامهم؟
أما في حال الاضطرار، كما يكون في المساجد العظيمة المزدحمة أحيانًا، فلا بأس بصلاة النساء أمام الرجال وعلى الجانبين، وفي ذلك جاء في المدونة في صلاة المرأة بين الصفوف: “قلت لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها. قال: وسألت مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلى الرجل خلف النساء لصلاة الإمام، قال: صلاتهم تامة ولا يعيدون. قال ابن القاسم: فهذا أشد من الذي يصلي في وسط النساء.” ([39])
وفي حال الاختيار: إما أن يوجد حائل أو لا يوجد.
أما عند وجود الحائل، وأمن الفتنة، فإن عامة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يجوزون مع الكراهة محاذاة الرجل للمرأة، وكذلك صلاته خلفها عند الجمهور دون الأحناف ([40]) وفي ذلك جاء في المدونة: “الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام قال: وقال مالك: ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكبير الإمام فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة وإن كانوا بين يدي الإمام، قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك. قال ابن القاسم قال مالك: وقد بلغني أن دارًا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان, قال مالك : وما أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجزأه.”([41]) ولعل المقصود بآل عمر النساء، فإن الأصل خروج الرجال للصلاة مع المسلمين، فإن كان المقصود جميع الآل، فإن النساء منهم كذلك. وبجواز الصلاة أمام الإمام لحاجة قال ابن تيمية ([42])
ولعل قول الجمهور هو الأقوى لعدم وجود المانع من التدليل أو التعليل، فإنهم إنما استدلوا بحديث: “أخروهن من حيث أخرهن الله.”([43]) ولا أصل له مرفوعًا. واستدلوا بقول عمر t ورفعوه: “من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له.” فاستحسنوا أن صلاة الرجال خلف النساء رغم الحائل باطلة وإن كانت صفوفهم مائة ([44]) ولا يصح أثر عمر t لا مرفوعًا ولا موقوفًا؛ بل قال النووي “باطل لا أصل له.”([45]) وقالوا: “ولأن الصف من النساء بمنزلة الحائط بين المقتدي وبين الإمام، ووجود الحائط الكبير الذي ليس عليه فرجة بين المقتدي والإمام يمنع صحة الاقتداء.”([46]) وليس كذلك، فإن الشبه غير واضح بين صف النساء والحائط الذي لا فرجة فيه. فإذا انضاف إلى ذلك أن الحاجز يمنع من الفتنة، فلا وجه لإبطال صلاة الرجال الذين يصفون خلف صفوف النساء أو بجنبهن مع وجود الحائل.
أما عند عدم وجود الحائل، فإن الأحناف يبطلون صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها، ويصححها الجمهور ([47]) ولكنهم اتفقوا على أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف ولا يلزمها أن تصاف أحدًا ([48])
أما بطلان الصلاة فلا دليل عليه، ولكن المنع من صف النساء بمحاذاة الرجال أو أمامهم من غير حائل هو الحق والصواب في حال الاختيار. فإن الأصل في صفوفهن أن تؤخر، فهكذا كان الحال في عهده r بلا خلاف، وحديث أنس السابق في صف العجوز خلفهم واضح المعنى ظاهر الدلالة. وحديث أبي هريرة المتقدم معنا عن خير الصفوف وشرها كذلك.
فإذا انضاف إلى الأصل الاستدلال بسد الذريعة إلى الفتنة لظهر وجه المنع. أما كون صف النساء أمام الرجال ذريعة إلى الفتنة، فظاهر لذوي البصائر والحجا، ولقد أمرهن رسول الله r ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال من الركوع كما تقدم، والعكس أشد وأخطر، ونظر الرجل إلى شابة تركع وتسجد أمامه في الصلاة فتنة له وتشتيت لذهنه وإذهاب لخشوعه؛ فإذا انضاف إلى ذلك أن من النساء في زماننا، وسيما في الغرب، من يأتين إلى المساجد بملابس زينة ضيقة، بل وغير ساترة للعورة، لزاد اليقين بوجوب المنع لدى كل عاقل وكل من كانت عنده أدنى بصيرة بمقاصد الشريعة وقواعدها وقدر الصلاة ومكانتها وحرمة المساجد وطهارتها.
ثم إذا انضاف إلى كل هذا أن كثيرًا ممن يحضون على جعل صفوف النساء بمحاذاة صفوف الرجال إنما يريدون بذلك مخالفة السنة ليثبتوا لغير المسلمين أن الرجل والمرأة يستويان، لتأكد المنع مرة أخرى. إن السنة هي وحي السماء والشريعة التي هي -كما قال ابن القيم -: عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله r أتم دَِلالة وأصدقَها ([49]) إن تقديم صفوف النساء الآن بزعم مساواتهن بالرجال لافتئات على رب الأرض والسماوات وفيه ما فيه من نسبة النقص إلى أحكامه، وإني والله لأخشى على مثل هؤلاء الفتنة وسوء الخاتمة.
إن صلاة النساء أمام الرجال أو على جانبي الصفوف مع تقدم بعضهن بحيث يراهن الرجال، ومن غير وجود الحائل، لا يسوغ في حال الاختيار بحال، وإن ساغ ولم يؤثر على صحة الصلاة في حال الاضطرار. أما عند وجود الحائل، فالأمر أهون وقد يلزم التوسيع في ذلك لضيق المساجد في بعض الأحوال وكون كثير منها لم يصمم ليكون مسجدًا، فتجوز صلاتهن أمام الرجال وعلى الجانبين، بل وأمام الإمام على الصحيح.
الفرع الثاني: مشروعية الحائل
أولا: هل تصح الصلاة خلف الحائل
إن الحائل إما أن يكون فيه نقوب تسمح بالرؤية أو لا يكون. وبينهما فرق في الحكم.
أما الحائل الذي لا يمنع من الاستطراق والرؤية، فالجماهير على جواز الصلاة خلفه ([50])، ولا ترد مسألة تواصل الصفوف على صفوف النساء، بل خير صفوفهن آخرها وهن يبدأن صفوفهن من الخلف إلى الأمام.
قال ابن الهمام حاكيًا مذهب الأحناف: “فالأول منه [الحوائل] حائط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب، فإن كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة، وعلى هذا الاقتداء من سطح المسجد أو المئذنة. ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم وإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الخلاف. وفي الخلاصة اختار الصحة.”([51])
وقال مالك: ” فمن صلى في شيء من أفنية المسجد الواصلة به من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزىء عنه ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه قال مالك فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت لأنها ليست من المسجد.”([52])
أما الصلاة خلف الحائل الذي لا نقب فيه ويمنع الرؤية والاستطراق، فالخلاف فيه أكثر، وإن جوزه المالكية، بل والجمهور عند الحاجة ([53]) ولكن منعه الحنفية والشافعية والحنابلة ([54]), ونقل ابن أبي شيبة في مصنفه المنع للرجل والمرأة عن عمر بسند لا يصح، و إبراهيم النخعي، والشعبي؛ ونقل الجواز عن أنس، وأبي هريرة، وأبي مجلز بأسانيد وصفها الألباني بالأصح ([55]). وسئل أبو مجلز عن المرأة لا ترى الإمام وتسمع التكبير فقال يجزئها ذلك ([56]). وقال ابن تيمية: ” وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل يجوز؛ وقيل لا يجوز؛ وقيل يجوز في المسجد دون غيره؛ وقيل يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة؛ ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا، مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التى فيها الإمام مغلقة، أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة كما تقدم فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال. وسئل عمن يصلي مع الإمام، وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه هل تصح صلاته أم لا؟ فأجاب الحمد لله نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء. والسنة في الصفوف أن يتموا الأول فالأول ويتراصون في الصف فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة والله أعلم.”([57]) قلت: الكراهة هنا للرجال دون النساء، فالسنة لهن أن يصلوا في مؤخر المسجد.
وفي معرفة السنن والآثار، روى البيهقي في باب (لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام): “…قال الشافعي فيمن كان في دار قرب المسجد أو بعيدا منه لم يجز له أن يصلي فيها إلا أن تتصل الصفوف به، وهو في أسفل الدار لا حائل بينه وبين الصفوف،…قال فإن قيل أفتروي في هذا شيئًا؟ قيل صلى نسوة مع عائشة في حجرتها، فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب. قال وكما قالت عائشة في حجرتها إن كانت قالته ([58]) … قال الشافعي في خلال ذلك وهذا مخالف للمقصورة المقصورة شيء من المسجد؛ فهي وإن كانت حائلا دون ما وراءها بينه وبين الإمام فإنما هو كحول الإسطوان أو أقل وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه.”([59])
إن الخلاف في هذه المسألة كثير مشهور، والأرجح صحة الصلاة والاقتداء مع عدم إمكان الرؤية عند الحاجة؛ وذلك إذا أمكنت المتابعة بالسماع، لعدم الدليل على المنع ولتصحيحهم جميعًا الصلاة على سطح المسجد، وقد تتعذر الرؤية. والصلاة في الرحبة عند الشافعية كالصلاة في المسجد وإن تعذرت الرؤية؛ قال الهيتمي – رحمه الله -: “…ويصح الاقتداء لمن فيها بمن في المسجد، وإن حال بينهما ما يمنع المرور والرؤية وغير ذلك.”([60])
ولكن، هل يفهم من ذلك أن نجعل ذلك الأصل في مصليات النساء؟ لا يظهر لي ذلك، بل الذي يظهر أن الحائل الذي نختاره عند بناء المسجد ينبغي ألا يمنع الرؤية والاستطراق، على أقل تقدير خروجًا من الخلاف. ونفصل القول في ذلك في المطلب القادم.
ثانيًا: هل تشرع إقامة حائل بين الرجال والنساء:
إن أمر إبقاء الحائل بين الرجال والنساء في المساجد مما كثر فيه الخلاف واللغط، بل وتبادل التهم. ولقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن استدعى انتباه وسائل الإعلام الأمريكية، والتي لا يخفى سر اهتمامها بهذا الأمر وكل ما يتعلق بالمرأة المسلمة.
لقد جاء على موقع إسلام أونلاين ما يأتي: “أثار قرار إزالة جدار يفصل بين المصلين الرجال والنساء في أكبر مساجد مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية انقسامًا بين رواد المسجد ما بين مؤيد ومعارض… وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الأحد 25-6-2006 أن الجدل أثير بعد إزالة جدار بارتفاع 8 أقدام كان يفصل بين النساء والرجال في مسجد دار السلام. وتم وضع علامات صغيرة مطبوعة مكتوب عليها: “المساحة المخصصة للنساء للصلاة” خلف مكان الجدار الذي تمت إزالته. وأوضحت الصحيفة أن الهدف من إزالة الجدار ليس للاختلاط بين الجنسين، ولكن لإتاحة الفرصة للوصول بسهولة إلى الإمام. وتعليقًا على قرار الإزالة، قال سليمان غالي العضو المؤسس في الجمعية الإسلامية بسان فرانسيسكو: “هذه إحدى الأمور الثقافية التي جاء بها المهاجرون دون أن يعطوها حقها من التفكير.”
وأضاف غالي، وهو أحد المؤيدين لإزالة الجدار: “أنا متأكد من أنه سيكون هناك هوية إسلامية أمريكية منفصلة عن تلك الموجودة بالشرق الأوسط وباقي العالم الإسلامي، حان الوقت للتخلص من تلك العادات السيئة.”
لا مانع: وبدوره قال د. مزمل صديقي، الرئيس السابق للجمعية الإسلامية بأمريكا الشمالية، لـ”إسلام أون لاين.نت” الإثنين 26-6-2006: “ليس في الإسلام ما يمنع اجتماع الرجال والنساء داخل المسجد سواء للصلاة أو أي هدف إسلامي آخر دون أي فصل بينهما بستار أو جدار”. وأضاف: “إذا كان الأمر يتعلق بتداخل صفوف الرجال والنساء في المسجد فلا ضرر من وضع حاجز منخفض لتحديد المساحة المخصصة للنساء” وشدّد صديقي على ضرورة عدم وضع النساء في قاعة منفصلة بالمسجد إلا في حالة عدم توافر مساحة لهن أو عدم وجود أي بديل لذلك.
وقال سيفيم كاليونكو، وهو كاتب أمريكي مسلم تركي الأصل: “كان الإمام دائمًا يخاطب الإخوة في خطبة الجمعة، أما الآن فنسمعه يقول الإخوة والأخوات؛ لأنه يرانا جميعًا، لقد أصبحت النساء الآن جزءًا من المجموعة.” وتقول سيدات مؤيدات لإزالة الجدار: إنه كانت لديهن مشكلات خاصة بسماع الخطبة، وغالبًا ما يقعن في أخطاء في حركات الصلاة نتيجة عدم رؤية المصلين.
“نريد الجدار” في المقابل عارض مسلمون ومسلمات من رواد المسجد، البالغ عددهم حوالي 400 شخص، قرار إزالة الجدار، حيث نظمت مجموعة من النساء مسيرة أمام المسجد، ولوّحن بلافتة مكتوب عليها: “نريد الجدار”. وقالت زينب الأندي (50 عامًا): “كمسلمة، أشعر بأمان عندما أصلي خلف الجدار، وكمحجبة لا أريد الاختلاط بالرجال”. فيما تذمر بعض رواد المسجد من الرجال، واتجه بعضهم للبحث عن مسجد آخر للصلاة. وقال عادل الدلالي (40 عامًا)، وهو سائق يمني: “لا أريد أن أشعر باضطراب وأنا أصلي بسبب وجود نساء في الخلف دون حاجز…. وكانت دراسة قد أجراها مجلس العلاقات الإسلامية – الأمريكية (كير) عام 2001 على أكثر من 1200 مسجد قد أظهرت أن 66% منها يصلي فيها النساء خلف جدار أو في قاعة منفصلة.”
لقد رأيت إيراد القصة كاملة لإيقاف السادة الفقهاء على الصورة الكاملة غير المجتزأة. لقد أتانا على موقع مجمع فقهاء الشريعة استفتاء حول هذه الواقعة ذاتها، فبينا أن المسألة مما يسوغ فيه الاختلاف، ولا ينبغي أن تسبب افتراق الصف. ولكننا أكدنا في ذات الوقت أن إزالة الحائل بحجة أنه لم يكن على عهد رسول الله r، مع عدم الإتيان بكل الاحتياطات والتدابير التي كانت بمسجده لمنع الفتنة أمر لا يظهر صوابه. وهذا مع افتراض أن النساء يلتزمن بالحجاب الذي التزمت به نساء الصحابة. لقد أكدنا على أن وجود الحائل المناسب الذي لا يمنع الرؤية والاستطراق هو الأقرب إلى الصواب، وعليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأنا في هذا المطلب أناقش مشروعية هذا الحائل.
أبعد قوم وادعوا أن الحاجز بين الرجال والنساء بدعة غير مشروعة، والصواب أنه من الوسائل التي تأخذ أحكام مقاصدها، ولم ينه عنه رسول الله r، فلما مات r وتغيرت أحوال الناس، ووجد المقتضي، صار المسلمون إلى جعل أماكن النساء في المساجد أكثر خصوصية وأبعد عن نظر الرجال، دون حرمان النساء من متابعة الإمام بالنظر والسماع، بل ومع ضمان الاستطراق أو التواصل بين مكاني النساء والرجال.
ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ بن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مع الرِّجَالِ قال كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وقد طَافَ نِسَاءُ النبي r مع الرِّجَالِ قلت أَبَعْدَ الْحِجَابِ؟ أو قَبْلُ قال إِي لَعَمْرِي لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قلت كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قال لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كانت عَائِشَةُ ل تَطُوفُ حَجْرَةً من الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُمْ فقالت امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قالت عَنْكِ وَأَبَتْ وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مع الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أنا وَعُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ في جَوْفِ ثَبِيرٍ قلت وما حِجَابُهَا قال هِيَ في قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لها غِشَاءٌ وما بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذلك وَرَأَيْتُ عليها دِرْعًا مُوَرَّدًا.”([61])
قال الحافظ في الفتح: “وفي رواية الكُشْمِيهَنيِّ ” حَجْزة ” بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب.”([62]) ولقد رجعت إلى المصنف ([63]) فوجدت تفسير حجزة في آخر حديث أم سلمة التالي لحديث عائشة رضي الله عنهما.
وهذا الحديث أصل في مشروعية اتخاذ الساتر في الطواف والصلاة بين النساء والرجال، فإنه فعل أم المؤمنين بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد.
قول رسول الله r: “صَلاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ من صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ من صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا.”([64]) ووجه الاستدلال أنه لو وفر للمرأة المزيد من الخصوصية في المسجد، لاجتمع لها شهود الجماعة والخير والحفاظ على الصيانة والستر. فإن قيل، فإن رسول الله r وأصحابه كانوا أحرى بهذا الخير، ولا ينبغي للمرء أن يظن أنه يسبق إلى فضل قصروا عنه، لكان الجواب بأنه دلنا على هذا الفعل، ولم يوجد المقتضي في زمنه r ووجد بعده. وإنه r ترك جمع القرآن وإدخال الحجر في البيت وغير ذلك مما فعله أصحابه من بعده.
وإن قيل تناقض نفسك فتمنع في بداية البحث من منع النساء من المساجد بحجة تغير الأحوال، وتستدل بذات الحجة على اتخاذ الحاجز، لكان الجواب بأن الفرق واضح بين الأمرين، فالأول نهى عنه رسول الله r صراحة دون الثاني الذي أشارت سنته إلى استحبابه أو وجوبه عند وجود المقتضي.
سد الذريعة إلى الفتنة. إن هذه القاعدة مما يستدل به هنا على مشروعية اتخاذ الحاجز، فإن النساء لعمري يأتين إلى المساجد في كامل زينتهن، ولقد ساءني أن إحدى الصحف الأمريكية التقطت صورًا للنساء في مسجد السلام المذكور أعلاه بعد هدم الحائل، وإذا ببعضهن شواب يلبسن السراويل الضيقة، وإلى الله المشتكى.
المصلحة. إن للنساء في زماننا، وهن يأتين للمساجد من أمكنة بعيدة، حاجة للمكث في المسجد فترات بعد الصلاة أو قبلها، وقد تحتاج أن تتخفف من بعض ثيابها أو تتكئ أو ترضع وليدها أو غير ذلك. ومع انكشاف مكانهن، لا أعتقد أن امرأة مسلمة تفعل شيئًا من ذلك أمام الرجال. يبقى إذًا للرجال من الحقوق في المساجد ما لا تحصله النساء من الراحة والتبسط في الحديث مع الإخوان وغير ذلك.
بقي أن المخالف إن تمسك بما كان عليه الحال في عهده r، لطالبناه ببقية ما كان عليه الحال في عهده r، ولسنا في ذلك نعجزه بطلب جيل كجيلهم، بل نطالب بذات الممارسات ونفس التدابير، ومنها:
أن تأتي النساء إلى المساجد تفلات ([65]) متلفعات بمروطهن ([66]) كما كن يفعلن رضي الله عنهن.
أن ينصرفن سريعًا بعد الصلاة كما فعلن رضي الله عنهن حتى أنهن لم يكن يعرفن من الغلس عند انصرافهن من صلاة الصبح ([67]).
ألا يستدير الرجال حتى تنصرف النساء ([68])
أن يخصص لهن باب لخروجهن ودخولهن ([69]).
أن يراعين الاحتشام في كلامهن ولا يلن القول ولا يرفعن الصوت عن قدر الحاجة ([70]).
ألا يحققن الطريق ([71]) ومن ذلك أن يتأخرن في الدخول والخروج حتى لا يزاحمن الرجال داخل المسجد على الأبواب وفي المصاعد وغيرها. وانظر حديث عائشة أعلاه وتركها لاستلام الحجر، وفيه ” كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ”
أما وقد قررنا مشروعية الحائل، فهل نقول بوجوبه؟ لعل الأمر يختلف من مسحد لآخر ففي بعض المساجد العظيمة التي يكون الفاصل فيها بين موقف الرجال والنساء شاسعًا، ربما لا يحتاج للفاصل وإن كان يستحب لراحة النساء وطمأنينتهن. أما في بعض المساجد الصغيرة، والتي ترى الرجال والنساء كبارًا وصغارًا متقابلين في جلستهم بعد الصلاة ينظر بعضهم إلى بعض، فالوجوب هنا لا يشك فيه. إن الكنائس قد صارت في الغرب مواطن عطب وأماكن ريبة؛ فهل نرضى ذلك لمساجدنا؟
ويبقى أنه في كثير من الأحوال يكون الحائل حائلا بين النساء والخشوع في الصلاة وسماع العلم، فيصير مصلى النساء وكأنه عالم آخر منفصل بالكلية عما يدور بالمسجد. لذا ينبغي التشديد وبكل حزم على حماية حق المرأة المسلمة في التعلم والاستفادة والخشوع؛ وكذلك حماية المساجد من أن تصير مصليات النساء المنفصلة فيها أمكنة للسمر وما يستتبعه في الغالب من الغيبة والنميمة والنزاع والخصومة. وإنما يكون ذلك بما يأتي:
- ألا تكون أمكنة صلاة النساء في حجرات منفصلة.
- ألا يكون الحائل مما يمنع الرؤية والسماع من غير تكلف والاستطراق بين القاعة الرئيسة ومصلى النساء. كيف لا والجمهور لا يصححون الصلاة – عند عدم الحاجة -خلف تلك الحواجز. إن هناك أنواع من الحوائل تؤدي هذا الغرض كزجاج المرايا الذي يمنع الرؤية من إحدى الجهتين، والخشب المعشق المعروف بالأرابيسك، ولا ينبغي أن يبالغ في ارتفاع الحاجز، وينبغي أن يترك ممر في جانب منه لحصول التواصل بين القاعتين والاستطراق. وقد يجعل للنساء طابق يصعدن إليه فيشرفن على القاعة الرئيسة للمسجد.
- أن تخصص دروس للنساء كما كان يفعل رسول الله r فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: “قالت النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ r غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لنا يَوْمًا من نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فيه فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ.”([72])
- ألا يمنعن من الخروج من وراء الحائل لسماع درس أو مراجعة الإمام. كيف نمنعهن، وقد كانت المرأة تجادل رسوا الله r في مسجده.
- ألا يهملهن الإمام، فعن جابر بن عبد الله قال: “شَهِدْتُ مع رسول اللَّهِ r الصَّلاةَ يوم الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ ثُمَّ قام مُتَوَكِّئًا على بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ على طَاعَتِهِ وَوَعَظَ الناس وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حتى أتى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فقال تَصَدَّقْنَ فإن أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ من سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فقالت لِمَ يا رَسُولَ اللَّهِ قال لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قال فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ في ثَوْبِ بِلالٍ من أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.”([73])
إن مثل هذه العناية بالنساء وذاك التفاعل معهن لا يتأتى إن كن في حجرة منفصلة تمامًا.
مكث الحائض في المسجد
إن المرأة قد تبقى في حيضها عشرة أيام من كل شهر على قول الأحناف، وهو الصحيح؛ وعند الجمهور خمسة عشر. وإنها في هذه المدة قد تحتاج لأن تصحب أولادها للمسجد، أو تكون هي نفسها من العاملات بالمسجد أو ملحقاته كالمدرسة وغيرها. فهل يجوز للمرأة الحائض المكث في المسجد وماذا عن المرور به دون المكث؟ وهل لملحقات المسجد وزياداته حكمه؟ هذا ما نناقشه في عجالة هنا لأنه مسطور ومفصل في كتب أهل العلم، فنعنى بالجوانب العملية وبيان الحلول.
إن عامة أهل العلم على منع الحائض من المكث في المسجد، ولكن الشافعية والحنابلة يسمحون لها بالمرور به. وسوف نناقش أدلة المانع والمبيح عند مناقشة مسألة المكث، ولكن أحببت التنبيه إلى أن الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية على جواز مرور الحائض والجنب بالمسجد.
منع من ذلك الجمهور، فالمذاهب الأربعة على المنع.
أباح ذلك الظاهرية والمزني من الشافعية ([74])
قول الله تعالى: ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾([75])
ذكروا أن زيد بن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة. ([76]) وقاسوا الحائض على الجنب.
أمر رسول الله r في صلاة العيد أن ” يَعْتَزِل الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى “([77])
قوله r لعائشة وقد حاضت في حجة الوداع: “…فَاقْضِي ما يَقْضِي الْحَاجُّ غير أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حتى تَغْتَسِلِي”([78]).
قوله r: ” فَإِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ ولا جُنُبٍ “([79]).
قول عائشة له، وقد أمرها أن تناوله الخمرة من المسجد: ” إني حَائِضٌ “([80]) قالوا لو لم يكن مستقرًا عدم دخول الحائض إلى المسجد لما قالته.
قوله r لعائشة وقد اعتذرت بحيضها عن مناولته الخمرة من المسجد: ” إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ “([81]) فها هو يأمرها بدخول المسجد، فلما استدركت، أكد لها أن لها الدخول.
وعن ميمونة: “كان رسول اللَّهِ r يَدْخُلُ على إِحْدَانَا وهي حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ في حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وهي حَائِضٌ ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا في الْمَسْجِدِ وهي حَائِضٌ أي بني وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ.”([82]).
دخول الكفار لمسجده وربطه لثمامة بن أثال في بعض سواريه، ومعلوم أنه يكون منهم الجنب بل يلزم ذلك.
بقاء أهل الصفة في مسجده، ومعلوم أنه يجنب بعضهم.
وعن عائشة قالت: “اعْتَكَفَتْ مع رسول اللَّهِ r امْرَأَةٌ من أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.”([83]) قالوا فدم الاستحاضة نجس ولم يمنع من بقائها بالمسجد.
وعن عائشة أن وَلِيدَةً كانت سَوْدَاءَ لِحَيٍّ من الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قالت فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لهم عليها وِشَاحٌ أَحْمَرُ من سُيُورٍ قالت فَوَضَعَتْهُ أو وَقَعَ منها فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وهو مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قالت فَالْتَمَسُوهُ فلم يَجِدُوهُ قالت فَاتَّهَمُونِي بِهِ قالت فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حتى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قالت والله إني لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتْ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قالت فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قالت فقلت هذا الذي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وأنا منه بَرِيئَةٌ وهو ذَا هو قالت فَجَاءَتْ إلى رسول اللَّهِ r فَأَسْلَمَتْ قالت عَائِشَةُ فَكَانَ لها خِبَاءٌ في الْمَسْجِدِ أو حِفْشٌ. ([84]) قال ابن حزم – رحمه الله -: ” فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي r والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه.”([85])
إنه لا شك أن اتفاق الأربعة على الخطأ أمر بعيد جدًا، ولكنه لا شك أنه ممكن الوقوع، وإلا كان اتفاقهم إجماعًا وحجة، وليس في دين الله كله دليل ينتهض لإثبات ذلك. يبقى أن مخالفتهم أمر لا ينبغي أن يتجاسر عليه إلا فحول الأئمة ومن بلغوا المنتهى في العلم كالطبري وابن حزم وابن تيمية وغيرهم.
أما أدلة المانع فلا تسلم من المعارضة
فاستدلالهم بأن زيد بن أسلم أو غيره قال في قوله تعالى: “وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ “([86]) معناه لا تقربوا مواضع الصلاة، يجاب عليه بجواب أبي محمد بن حزم: “ولا حجة في قول زيد…لأنه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ﴾ ([87]) وروي أن الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة.”([88]) ويجاب بالتفريق بين الحائض والجنب، فالأولى حدثها يطول ولا تقدر على رفعه بخلاف الثاني. ([89]) ودخول الكفار إلى مسجده وهم يقينًا مجنبون دليل آخر.
واستدلالهم بأمر رسول الله r في صلاة العيد أن ” يَعْتَزِل الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى “([90]) يجاب عليه بأن المصلى ليس مسجدًا وإنما هو مكان في العراء، فإنما قصد أن يعتزلن صفوف الصلاة فلا يقمن بينها، وهذا ما ينبغي لهن فعله في المسجد كذلك. ولقد جاءت روايات تشهد بأن ذلك هو المعنى المقصود ففي رواية لمسلم: “فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ”([91]) وفي المعجم الكبير: “أَمَرَنَا النبي r أَنْ نُخْرِجَ في الْعِيدَيْنِ ذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَشْهَدْنَ مع الْمُسْلِمِينَ دَعْوَتَهُمْ وَصَلاتُهُمْ وَتَعْتَزِلَ الْحُيَّضُ الصَّلاةَ.”([92]) ومثله في مسند إسحاق بن راهويه ([93]) وفي حديث أبي خيثمة عن عاصم “والحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.”([94])
واستدلالهم بقوله r: “غير أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حتى تَغْتَسِلِي.”([95]) يجاب عليه بأنه نهي عن الطواف لا عن دخول المسجد؛ بل استدل المبيح به لأنه r لم يستثن دخول المسجد، وإن كان بعيدًا لأن دخوله ليس من أركان الحج أو واجباته.
واستدلالهم بقوله r: ” فَإِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ ولا جُنُبٍ “([96]) يجاب عليه بضعف الحديث فإنه من طريق جسرة بنت دجاجة، وقد قال البخاري “عندها عجائب،” وضعف الحديث رهط من أهل العلم، وإن حسنه البعض.
واستدلالهم بقول عائشة ل ” إني حَائِضٌ “([97]) يجاب عليه بأنه فهم منها، ولا يبعد فإن الحائض تمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك، فلعها ظنت أنها تمنع من المساجد وأرادت الاستيضاح منه r.
وحديث ” إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ “([98]) قوي في دلالته على مذهب المبيح واعتراضهم بأنه أمرها بإخراج يدها من الحجرة لا دخول المسجد لا يسلم، ولا يظهر من الحديث. بقي أن هذا الدليل يحتج به على من منع المرور دون المكث.
أما أقوى ما عند المبيح من الدليل فهو مع البراءة الأصلية ثبوت بقاء النساء، والرجال والكفار والمسلمين في مسجده r، فلو كانت الحائض تمنع عن المسجد لنجاسة معنوية، فإن رسول الله r قال: “سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ.”([99]) والكافر أولى بهذه النجاسة منها. وإن كان منعها لنجاسة حسية، فهذه إحدى نسائه “اعْتَكَفَتْ …فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا.”([100]) ودم الاستحاضة نجس ولم يمنع من بقائها بالمسجد.
إن القول بمنع الحيض من المساجد، رغم ما قدمنا، هو الأشهر وذلك متوقع كونه مذهب الأربعة، والأرجح أنه سيبقى كذلك. لذا، فهل من سبيل إلى عدم حرمانها من المجيء إلى المركز الإسلامي لسماع درس علم أو اصطحاب أولادها أو غير ذلك من الحاجات التي تقضيها في المراكز الإسلامية؟
الظاهر أن ذلك ممكن، فإن هذه المراكز الإسلامية فيها مرافق كثيرة أحدها المسجد أو قاعة الصلاة. ولكن هل هذه المرافق لها حكم المسجد؟ هذه مسألة رحبة المسجد والزيادة عليه المشهورة عند أهل العلم فنناقشها لمعرفة ما إذا كان للحائض المكث في تلك الأمكنة عند من يمنعها من المسجد.
فصل: في حكم الزيادة على المسجد
اختلفت آراء أهل العلم حول رحبة المسجد، وامتد الخلاف إلى داخل المذهب الواحد. وفرق البعض بين الزيادة المحوطة بسور وغيرها وفرق آخرون بين بعض الأحكام وبعضها فجوزوا للجنب والحائض الإقامة في الرحبة ومنعوا الإقطاع فيها لأنها من المسجد، وهي بلا شك من الأوقاف ولها أحكامها إن تلفظ بذلك الواقف أو كانت مواتًا وضمت إلى حريم المسجد.
والظاهر أن الشافعية هم أكثر المذاهب إدخالا للرحبة في أحكام المسجد، والصحيح عند الباقين أنه ليس لها حكمه.
قول السادة الحنفية:
جاء في الدر المختار: “وأما المتخذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف رفقا بالناس لا في حق غيره. به يفتى. (نهاية) فحل دخوله لجنب وحائض كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع.”([101]) ولكن قال العيني – رحمه الله -: “وحكم رحبة المسجد حكمه لأنها منه.”([102]) ولا أدري إن كان متأثرًا في ذلك بالعراقي والدجوي الشافعيين الذين تحمل عنهما إسناده إلى البخاري.
قول السادة المالكية:
قال ابن فرحون / في تبصرة الحكام “والأحسن أن يكون مجلس قضائه حيث الجماعة جماعة الناس وفي المسجد الجامع , إلا أن يعلم ضرر ذلك بالنصارى وأهل الملل والنساء الحيض فيجلس في رحبة المسجد.”([103])
قول السادة الشافعية:
قال النووي في روضة الطالبين: “وأما رحبة المسجد فعدها الأكثرون منه ولم يذكروا فرقا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج إن انفصلت فهي كمسجد آخر.”([104])
ويبين الشافعية المقصود بالرحبة عندهم، فيقول الهيتمي: “… ويقتضي أن الزيادة لها حكم المسجد مطلقا، وذلك أنهم ألحقوا رحبة المسجد به وهي الخارجة عنه المحوط عليها لأجله سواء أبنيت معه أم لا فيحرم المكث فيها على الجنب ويصح الاقتداء لمن فيها بمن في المسجد، وإن حال بينهما ما يمنع المرور والرؤية وغير ذلك.”([105])
وقال السيوطي: “… وأما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب قال صاحب الشامل والبيان هي ما كان مضافا إلى المسجد وعبارة المحاملي هي المتصلة به خارجه. قال النووي: وهو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح إنها صحنه؛ وقال البندنيجي هي البناء المبني بجواره متصلا به؛ وقال القاضي أبو الطيب هو ما حواليه؛ وقال الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه، ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا، وهو المذهب، وقال ابن كج إن انفصلت عنه فلا.”([106]) وعمدتهم في ذلك من التعليل ما ذكره السيوطي إذ قال: “ضابط: كل محرم فحريمه حرام …ويدخل في هذه القاعدة … وحريم المسجد فحكمه حكم المسجد ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه.”([107])
ويبين الحافظ أن الرحبة ليست تمامًا كالمسجد فيقول: “… وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد مع اعطائها حكم المسجد في الصلاة فيها فقد أخرج مالك في الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول من أراد ان يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة.”([108])
ولكن حتى الشافعية لا تكون الزيادة على المسجد عندهم منه إلا أن ينوي الواقف ذلك، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى: “( وسئل ) رضي الله تعالى عنه عما إذا جدد مسجد وزيد على حدوده التي كان عليها فهل للمزيد حكم المسجد … ؟ ( فأجاب ) بقوله إنما يكون للمزيد حكم المسجد في صحة الاعتكاف وغيرها إن وقفت تلك الزيادة بأرضها مسجدا بأن تلفظ الواقف بذلك أو كانت أرض الزيادة مواتا ونوى بالبناء فيها إحياءها مسجدا وإن لم يتلفظ بذلك فإن انتفى قيد مما ذكرناه لم يكن للزيادة حكم المسجد.”([109])
أما الحنابلة فوقع عندهم الاختلاف، وحل الإشكال التفريق بين الرحبة والزيادة المحوطة بسور وغير المحوطة، فالصحيح أن المحوطة من المسجد، قال الرحيباني: “…وعلم مما تقدم أن رحبة المسجد لو كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس بها لأنها من المسجد.”([110]) وهم يجوزون للحائض أن تقيم في الرحبة، فيقول الرحيباني – رحمه الله -: “ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به.”([111])
ويعللون ذلك بحديث عن عائشة ل،لم يثبت، فيقولون: “…وتتحيض ندبا معتكفة حاضت بخباء في رحبته أي المسجد غير المحوطة، إن كانت له رحبة، وأمكن تحيضها فيها بلا ضرر في ذلك على أحد، لحديث عائشة كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله r بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن رواه أبو حفص.”([112]) ويبين شيخ الإسلام وجه التفريق فيقول: “كما أن صحن المسجد هو تبع للمسجد ويشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة.”([113])
وسبقه إلى البيان ابن قدامة فقال: “وظاهر كلام الخلاقي أن رحبة المسجد ليست منه وليس للمعتكف الخروج إليها لقوله في الحائض يضرب لها خباء في الرحبة. والحائض ممنوعة من المسجد، وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا… قال القاضي إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد فكأنه جمع بين الروايتين وحملهما على اختلاف الحالين.”([114])
الترجيح والتوصية
إن الظاهر من كلامهم أن الجمهور يعطون الرحبة المتصلة بالمسجد والمحوطة بسور حكم المسجد أو بعض أحكامه. ولكن الظاهر أيضًا أنهم يفرقون بين ما زيد على المسجد توسعة له، وما لم يكن كذلك. وأرفع ما عندنا في الباب هو ما في الموطأ عن عمر والظاهر منه التفريق في الحكم بين الرحبة والمسجد.
إن حل الإشكال هو في إقامة المراكز الإسلامية مع تحديد واضح للمسجد، وفصل له عن المرافق الزائدة عليه. أما كون المرافق الملحقة به في ذات البناء، فلا أثر له على الحكم لأن الأبنية في زماننا، وسيما في الغرب قد تشمل ألف محل لكل منها غرض غير الآخر.
إنه إن كان للمسجد مرافق ملحقة به فيما يسمى بالمركز الإسلامي، فإن العرف يقضي بأنها ليست منه، ففيها بيع وشراء وإنشاد ضوال ومراحيض وغير ذلك مما لا يجوز في المساجد.
إن المرأة المسلمة وإن اعتقدت عدم جواز مكث الحائض في المسجد يجوز لها أن تكون في بعض هذه الغرف، ويكون ذلك الجواز على قول الجمهور الأعظم، فلا ينبغي التحرج من فعل ذلك.
والواجب على القائمين على المراكز الإسلامية مراعاة حاجة المرأة إلى تلك الأماكن المنفصلة عن قاعات الصلاة وأن يهيئوها لراحتها ويزودوها بشاشات العرض التي تمكنها من متابعة حلق العلم وغير ذلك.
إن الحافظ قال في شرحه لحديث إخراج النساء إلى العيدين: “إن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد.”([115]) قلت: الأغلب في زماننا وفي الغرب خاصة، أنه لا توجد مثل هذه المجالس إلا في المساجد.
مشروع قرار مجمعي
إن المسجد في الغرب هو سفينة نوح للمسلمين المقيمين بتلك البلاد، ولدوره أهمية تفوق نظيرتها في الشرق على عظيم قدرها. ويوصي المجمع المسلمين في تلك البلد بالعناية بإقامة المساجد وعمارتها وتجهيزها بكل ما يلزم لتكون موئل المسلمين ومهوى أفئدتهم.
إن للمرأة المسلمة بالغرب حاجة بالمسجد تفوق حاجة نظيرتها بالشرق، لذا وجب عدم منع إماء الله من بيوت ربهن، وتهيئة المساجد لملاءمة حاجاتهن وحفظ صيانتهن.
إن وضع الحواجز الملائمة بين الرجال والنساء هو الأنسب للمساجد بالغرب، بل يجب في أكثر الأحوال صيانة للمرأة وحرصًا على راحتها، وسدا لذريعة الفتنة، وحراسة لطهارة المساجد، وحفاظًا على قدسية الصلاة.
إن الحوائل التي توضع بين الرجال والنساء ينبغي ألا تمنع الرؤية من جهة النساء والسماع والاستطراق، وينبغي أن تكون مصليات النساء في ذات القاعة الرئيسة للمسجد، ويتوفر بها ما بهذه القاعات من أسباب الراحة والإكرام.
لا يعاب حضور النساء لمجالس العلم من غير وجود حائل بينهن وبين الرجال سوى المباعدة المعقولة بين مجالسهن ومجالس الرجال.
إن أئمة المساجد والقائمين عليها ينبغي أن يراعوا حاجة المرأة المسلمة للعلم كما كان رسول الله r يفعل، ومن ذلك تخصيص دروس للنساء والحرص على أن توفر لهن أسباب المشاركة في الدروس العامة والانتفاع بها.
إن الجمهور يجيزون للمرأة الحائض المرور بالمسجد ويمنعونها من المكث فيه، وخالف البعض فجوز الأمرين، والمنبغي أن يترك الأمر لاختيار المرأة المخاطبة بهذا التكليف.
الصحيح أن للمرأة في الغرب المكث في المرافق الملحقة بالمساجد داخل المراكز الإسلامية، فإنه ليس لها حكم المسجد في الصحيح، وعلى ذلك استقر العرف الخاص بتلك البلاد. والواجب على القائمين على أمر المراكز الإسلامية تخصيص أماكن للنساء غير قاعة الصلاة وأن يهيئوها لراحة المرأة المسلمة ويزودوها بشاشات العرض التي تمكنها من متابعة حلق العلم وغير ذلك.
المراجع
1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل [كتاب]/ المؤلف محمد ناصر الدين الألباني. – بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي، 1399هـ. – الأولى. – خرج فيه أحاديث (منار السبيل في شرح الدليل) أحد الشروح في الفقه الحنبلي للعلامة إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفى سنة (1353هـ) والذي شرح فيه (دليل الطالب) أحد المتون الحنبلية المعتمدة للعلامة مرعي بن يوسف المقدسي المتوفي سنة (1033هـ).
2- إعلام الموقعين عن رب العالمين [كتاب]/ المؤلف محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القيم)/ المحقق طه عبد الرؤوف سعد. – بيروت: دار النشر ودار الجيل، 1973 م.
3- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد [كتاب]/ المؤلف محمد عبد الكبير البكري يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، أبو عمر/ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. – المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387 هـ.
4- الدر المختار [كتاب]/ المؤلف محمد بن علي بن محمد الحنفي الحصكفي. – بيروت: دار الفكر، 1386 هـ.
5- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية [كتاب]/ المؤلف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني/ تقديم حسنين محمد مخلوف. – بيروت: دار المعرفة.
6- الفتاوى الكبرى الفقهية، تأليف: ابن حجر الهيتمي، دار النشر: دار الفكر.
7- صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت – 1392، الطبعة: الطبعة الثانية.
8- مسند أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي. بيروت.
9- المبسوط [كتاب]/ المؤلف أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، شمس الأئمة. – بيروت: دار المعرفة. – شرح فيه شمس الأئمة السرخسي (ت 483هـ) كتاب (الكافي) لأبي الفضل المروزي المعروف بالحاكم الشهيد (ت 344هـ) والذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية (المبسوط والزيادات، والجامع الكبير والصغير، والسير الكبير والصغير) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ).
10- المجموع شرح المهذب [كتاب]/ المؤلف يحيى بن شرف النووي. – بيروت: دار الفكر، 1997م. – من أجمع كتب الفقه الشافعي بل الإسلام، شرح فيه النووي (المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) ولم يتمه، وإنما شرح ربع الأصل في 9 مجلدات، ثم مات، وجاء تقي الدين السبكي (ت 756هـ) فزاد ثلاثًا، ثم مات، ولم يتمه إلا الحضرمي والعراقي ثم محمد نجيب المطيعي.
11- المحلى [كتاب]/ المؤلف علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري/ المحقق لجنة إحياء التراث العربي. – بيروت: دار الآفاق الجديدة.
12- المدونة الكبرى [كتاب]/ المؤلف مالك بن أنس. – بيروت: دار صادر. – مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه وردت للإمام مالك، جمعها وصنفها عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون (ت 240هـ ) والذي رواها عن عبد الرحمن بن القاسم (ت 191هـ) عن الإمام مالك بن أنس.
13- المصنف [كتاب]/ المؤلف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أبو بكر/ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. – بيروت: المكتب الإسلامي، 1403 هـ.
14- المعجم الكبير [كتاب]/ المؤلف سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني/ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. – الموصل: مكتبة الزهراء، 1404 هـ.
15- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني [كتاب]/ المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. – بيروت: دار الفكر، 1405 هـ. – الأولى. – ليس يقتصر على المذهب الحنبلي، بل يعرض الخلاف داخل وخارج المذهب، مع الاستدلال والترجيح، فكان عمدة كتب الفقه المقارن، ولم يدانه في بابه كتاب.
16- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [كتاب]/ المؤلف علاء الدين الكاساني. – بيروت: دار الكتاب العربي، 1982 م. – من أجل كتب الفقه الحنفي وهو في أصله شرح لكتاب تحفة الفقهاء لأستاذ المصنف ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي (ت 539هـ) والذي هو شرح لمشكلات كتاب القدوري (ت 428هـ) واستدراك لبعض ما فاته.
17- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام [كتاب]/ المؤلف إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري/ المحقق جمال مرعشلي. – بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ.
18- روضة الطالبين وعمدة المفتين [كتاب]/ المؤلف يحيى بن شرف النووي، محيي الدين أبو زكريا. – بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 هـ.
19- سنن أبي داود [كتاب]/ المؤلف سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي/ المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد. – بيروت: دار الفكر.
20- سنن أبي داود (بتحقيق مشهور) [كتاب]/ المؤلف سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي/ بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان وحكم الألباني على درجة الحديث. – الرياض: مكتبة المعارف. – الأولى.
21- سنن البيهقي الكبرى [كتاب]/ المؤلف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي/ المحقق محمد عبد القادر عطا. – مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 1414 هـ.
22- شرح فتح القدير [كتاب]/ المؤلف كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام). – بيروت: دار الفكر. – الثانية. – شرح فيه (الهداية شرح البداية) والذي شرح فيه الإمام العلامة المرغيناني (ت 593هـ) متن (بداية المبتدي) له (أي الماتن هو الشارح) ومتن البداية هو أحد المتون الحنفية المعتمدة والذي جمع فيه مسائل القدوري والجامع الصغير لمحمد بن الحسن.
23- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان [كتاب]/ المؤلف محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم التميمي البستي/ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. – بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414 هـ. – الثانية.
24- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر) [كتاب]/ المؤلف محمد بن إسماعيل البخاري. – بيروت: دار ابن كثير واليمامة، 1407 هـ. – الثالثة.
25- صحيح مسلم [كتاب]/ المؤلف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري/ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي. – بيروت: دار إحياء التراث العربي.
26- عمدة القاري شرح صحيح البخاري [كتاب]/ المؤلف محمود بن أحمد العيني، بدر الدين. – بيروت: دار إحياء التراث العربي.
27- فتح الباري شرح صحيح البخاري [كتاب]/ المؤلف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ المحقق محب الدين الخطيب. – بيروت: دار المعرفة.
28- كشاف القناع عن متن الإقناع [كتاب]/ المؤلف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي/ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال. – بيروت: دار الفكر، 1402 هـ. – شرح فيه (الإقناع) للحجاوي (ت960هـ).
29- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى [كتاب]/ المؤلف مصطفى السيوطي الرحيباني. – دمشق: المكتب الإسلامي، 1961م. – شرح (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) للكرمي (ت 1033هـ) جمع (الإقناع) للحجاوي (ت960هـ) و(منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات) لابن النجار (ت972هـ) والذي جمع بين (التنقيح المشبع) للمرداوي (ت885هـ) و(المقنع) لابن قدامة (ت620هـ).
30- معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي [كتاب]/ المؤلف أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي/ تحقيق: سيد كسروي حسن. – بيروت: دار الكتب العلمية.
([1]) صحيح ابن حبان ج4/ص476 عن ابن عمر. وصححه المنذري والذهبي وابن حجر.
([4]) صحيح ابن حبان ج4/ص490 عن أبي ذر
([6]) (ق) صحيح مسلم ج2/ص715 عن أبي هريرة
([9]) التمهيد لابن عبد البر ج23/ص401-403
([13]) سنن أبي داود ج1/ص156 عن ابن مسعود
([16]) التمهيد لابن عبد البر ج23/ص401-402
([17]) التمهيد لابن عبد البر ج23/ص401-403
([18]) بدائع الصنائع ج1/ص275 وانظر المجموع ج5/ص12
([20]) (ق) صحيح مسلم ج1/ص327 عن ابن عمر
([24]) انظر بدائع الصنائع ج1/ص275
([26]) (ق) صحيح مسلم ج1/ص327 عن ابن عمر
([27]) (ق) صحيح مسلم ج1/ص327 عن ابن عمر
([28]) وحسن الزيادة النووي في المجموع ج5/ص12
([33]) شرح النووي على صحيح مسلم ج4/ص159
([34]) سنن أبي داود ج4/ص369. والحديث وإن كان فيه مقال، فإن ما قبله يشهد له، وأصول الشريعة كذلك.
([40]) انظر المبسوط للسرخسي ج1/ص183 ومواهب الجليل ج2/ص107 والمجموع ج3/ص224 و كشاف القناع ج1/ص329.
([43]) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية: لم أجده مرفوعًا. وقال الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة: موقوف على ابن مسعود.
([44]) المبسوط للسرخسي ج1/ص183
([46]) المبسوط للسرخسي ج1/ص183
([47])انظر المبسوط للسرخسي ج1/ص183 ومواهب الجليل ج2/ص107 والمجموع ج3/ص224 و كشاف القناع ج1/ص329.
([49]) «إعْلام المُوَقِّعِين» لابن القَيِّم (ج3/ص11).
([50]) شرح فتح القدير ج1/ص381 ومجموع الفتاوى ج23/ص407 وعمدة القاري ج5/ص262
([52]) سنن البيهقي الكبرى ج3/ص111
([53]) عمدة القاري ج5/ص262 ومعرفة السنن والآثار ج2/ص387
([56]) مصنف ابن أبي شيبة ج2/ص35
([58]) لم يثبت عنها، بل قال الألباني في إرواء الغليل: لم أجده. إرواء الغليل رقم 543
([59]) معرفة السنن والآثار ج2/ص387
([60]) الفتاوى الفقهية الكبرى ج3/ص229
([64]) سنن أبي داود ج1/ص156 عن ابن مسعود
([65]) وحسن الزيادة النووي في المجموع ج5/ص12
([70]) سنن أبي داود ج4/ص369. والحديث وإن كان فيه مقال، فإن ما قبله يشهد له، وأصول الشريعة كذلك.
([74]) انظر المحلى ج2/ص184 و نيل الأوطار ج1/ص287
([82]) مسند أحمد بن حنبل ج6/ص331. وقال الشوكاني في النيل “له شواهد” نيل الأوطار ج1/ص286
([89]) انظر كلاما نفيسا لابن تيمية في التفريق بينهما وعذر الحائض والرفق بها عند ذكره لأحكام طوافها في مجموع الفتاوى ج26/ص208
([93]) مسند إسحاق بن راهويه ج5/ص210
([94]) الجمع بين الصحيحين ج4/ص301
([105]) الفتاوى الفقهية الكبرى ج3/ص229
([106]) الأشباه والنظائر ج1/ص125
([107]) الأشباه والنظائر ج1/ص125
([109]) الفتاوى الفقهية الكبرى ج3/ص271
([110]) مطالب أولي النهى ج4/ص196
([111]) مجموع الفتاوى ج26/ص208
([112]) مطالب أولي النهى ج2/ص245