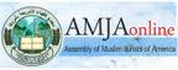كتب لصحيفة الوسط
الحمد لله
قبل أسبوعين ذكر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن بلاده منفتحة للحديث مع أية حركة إسلامية تنبذ العنف، مشيرا إلى أن الزعماء العرب خدعوا فرنسا وصوروا تلك الحركات على أنها الشيطان. إن أبوابًا وقنوات كثيرة ستفتح في مجتمع ما بعد الثورة، ومنها قنوات التواصل المباشر بين آحاد المسلمين والعالم الخارجي، وكذلك بين هذا والإسلاميين، كما يظهر من كلام الوزير الفرنسي وردود الفعل المرحبة من قطاعات واسعة من الإسلاميين. إن الحوار لن يكون فقط بين الإسلاميين والحكومات الخارجية، بل الجزء الأهم منه هو ما سيكون بينهم وبين القوى الفاعلة في
تلك المجتمعات كرجال الدين والسياسة والفكر. والأمر في الحالتين ذو أهمية وخطر.
في الفقرات القليلة القادمة أعرض إلى ما يوجبه انفتاح الأبواب بين عموم الناس والعالم الخارجي من تراتيب، وفي المقال القادم يكون الكلام – إن شاء الله – عن انفتاح قنوات التواصل بين
الإسلاميين والقوى الفاعلة في المجتمعات الأخرى.
أما بالنسبة إلى آحاد الناس، فكما ذكرت في المقال الأول فإن حكومات ما بعد الثورة يتوقع أن تسعى إلى نهضة اقتصادية تأخذ بالنماذج الصينية والهندية والماليزية والتركية والبرازيلية، والتي اختلفت في بعض تفاصيلها، لكنها اشتركت في أنها لم تصارع الأمواج بل ركبتها، فسعت إلى الاستفادة من كل إيجابيات العولمة، مع التقليل من مضارها. هذا الواقع الجديد سيأتي بتحديات
جديدة، فكثير من المصريين سيعملون في تلك الشركات ويخالطون الأجانب داخل مصر وخارجها في سفرات لحضور دورات أو مؤتمرات أو للتدريب…الخ. إن هذا الأمر إن لم يكن في أصله جديدًا، لكن الجديد سيكون حجمه. كذلك فإن مستخدمي الإنترنت ازدادوا بعد الثورة، وهذا يعني أن شريحة أوسع من المصريين ستخالط في هذا العالم الافتراضي الشاسع أقوامًا شتى، مما يعني ورود شُبَه وأحوال عليهم لا عهد لهم بها من قبل، بل ومن تحديات هذا العالم أنه يوفر فضاءات مغايرة للتواصل الاجتماعي مما يؤدي إلى انحسار دور الضغط الاجتماعي التقليدي في حماية الدين أو المفاهيم السائدة عنه في المجتمع المحلي خطأً كانت أو صوابًا.
إن الإسلام دين عالمي في أصل ماهيته ومن بداية دعوته، قال تعالى: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ” [الأنبياء:107] و “إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ” [يوسف: 104]. وإن تحديات الانفتاح الجسيمة تحمل في رحمها فرصًا عظيمة، ومن أجل اغتنامها يجب العناية بعموم المسلمين روحيًا وفكريًا وسلوكيًا وتزويدهم بخرائط واضحة عن سبل التعامل مع الآخر وتمييز ما عنده من حق وباطل وغث وثمين، ومن ثم الاستفادة الواعية منه والتأثير الإيجابي عليه. وأرى من الأمور الهامة في ذلك الصدد:
- إحياء الربانية ورفع المنسوب الإيماني عند عموم الناس والتركيز على محبة الله ورسوله ودينه وعباده المسلمين. فإن الجواب العقلي على الشبهات التي تعرض على القلوب لا يكفي – على ضرورته – في صد خيل الشيطان ورجله إذا أغاروا، وما أكثر ما يفعلون.
- الرد على أمهات الشبهات بجواب عقلي محرر واف، محافظ على الأصول ومراع للأعراف العالمية السائدة في الطرح والتفسير. ثم يجب استفاضة البلاغ بهذه الأجوبة. وربما لزم إنشاء
مؤسسات تعنى بذلك ويكون لها حضور قوي ومشاركة فاعلة على الشبكة العنكبوتية، ولعل التنسيق مع المقيمين في الغرب من المسلمين مهم لإنجاز هذه المهمة على الوجه الأكمل
والأجمل. - لا شك أن الروابط الاجتماعية لها أثر على استبقاء واستحياء الصلة بين آحاد الناس وأديانهم حقًا كانت أو باطلاً. قال تعالى عن إبراهيم: “وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا.” [العنكبوت: 25] أي لتجتمعوا على عبادتها مودة وألفة بينكم. إنه لا بد مع التغيرات المتوقعة تعويض الضعف الواقع والمتوقع في الشبكة الاجتماعية التقليدية. إن مخالطة البعض لزملائهم في العمل، والذين يمكن أن يكونوا من غير أبناء البلد وأهل الملة قد يربو على مخالطته لأهله وجيرانه. فإذا أضفت إلى ذلك مخالطته لآخرين في ذلك العالم الافتراضي إذا عاد إلى بيته وجلس أمام شاشة الكمبيوتر، ظهرت خطورة الأمر. ومن المطلوب أن تقوم المساجد بدور أعظم في تقوية اللحمة الاجتماعية والمشاعر الولائية. لا بد أن يعود للمسجد دوره ليصير مهوى أفئدة المسلمين ومستراحهم، فيه يلتقون ويتعارفون ويجتمعون على عمل الخيرات أو تحصيل حاجة النفس من المباحات، كالرياضة والترفيه…الخ.
- ومن جهة أخرى، فإن الإيمان الكامل هو الذي ينبع من قناعة شخصية فردية راسخة، ولا يحتاج إلى أعواد داعمة ليستوي على ساقه. إن هذه الفردية هي التي دعا القرآن إليها المشركين فقال: “قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.” [سبأ: 46] إن بناء الفرد المؤمن الواثق من دينه الواعي بما حوله سيكون سبيل النجاة الأعظم من المهلكات.
دواؤك فيك وَما تُبصِر — ودَاؤُك منك وما تَشعُرُ
وتزعم أنك جرم صَغير — وفيك انطَوى العالم الأكبَرُ
- إعادة نظر بعض الإسلاميين في موقفهم النظري أو العملي من تدريس المنطق والعناية به، فإن دراسة المنطق المصفى من الشوائب الفلسفية الباطلة أمر مهم لبناء المحاور القوي العاقل، وفي ذلك ينقل العلامة محمد الأمين الشنقيطي عن الشيخ مختار بن بونة قوله:
فإن تقل حرَّمه النواوي — وابن الصلاح والسيوطي الراوي
قلت نرى الأقوال ذي المخالفة — محلها ما صنف الفلاسفة
أما الذي خلَّصه من أسلما — لابد أن يُعْلم عند العلما
ولكن هذا يرد في حق من ذاق طعم السنة وأدرك حلاوتها، ولذلك يقول الأخضري صاحب السلم فيما ينقله أيضًا العلامة محمد الأمين:
والخلف في جواز الاشتغال — به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنوواي حرما — وقال قوم ينبغي أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة — جوازه لكامل القريحة
ممارس السنة والكتاب — ليهتدي به إلى الصواب
وإنما كان ذلك مهمًا لضرورة الاستدلال بالحجاج العقلية الكلية، فالإلزام العقلي هو السبيل إلى إقناع المخالفين في أصل الملة، ولهذا أيد الله الرسل بالمعجزات، وكان حوار القرآن المكي للمخالفين قائمًا على دليل العقل وطرق الجدل المستقيمة كالسبر والتقسيم والإلزام والاستفهام التقريري والقياس الإضماري والرد بالنقض والمعارضة…الخ ومن ذلك قول الله تعالى: “وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ” [يس 79-80] وقوله: “لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ” [الأنبياء: 22].[1]
ومما ينصح به أيضًا في مقام المحاورة:
- حسن التأتي: قال تعالى: “وَلَا تُجَـٰدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ” [العنكبوت: 46]. وقال: “وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا” [البقرة: 83] ومن أهم ما ينبغي الحذر منه السخرية من المحاور.
- التفريق بين الكتابي والملحد وذي الشأن والعامي والمفتري والمستفهم وسيء الأدب والمهذب، فلكل مقام مقال ولكل داء دواء، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا — مضر كوضع السيف في موضع الندى.
- الدقة في العزو وتصحيح النقل ومطالبة الخصم بتصحيحه، فلا فائدة في إضاعة الوقت في تفنيد قول عالم أو مؤرخ وهو لم يثبت عنه. وكذلك الوضوح في العبارة والاستفسار عن الغامض من عبارات المحاور، حتى لا يجهد نفسه في الرد على معنى لم يرده المحاور.
- البَداءة بالقدر المشترك بين المتحاورين كما في قوله –تعالى-: “وَقُولُوا ءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ” [العنكبوت: 46] فيستدل على المختلف بالمؤتلف.
- تجنب الإطالة في جزئيات لا مدخل إلى الاقتناع بها سوى التسليم الإيماني، والتركيز على الكليات والمسائل الكبار في العقيدة: كالتوحيد والرسل واليوم الآخر وصدق نبوة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وفي الفقه: كتحريم الخمر والزنا والربا، وفي الأخلاق والتزكية. وهذا يجري أيضًا على التاريخ، فينبغي أن تستعمل الحوادث العظمى التي لا يجد الخصم لها مدفعًا كبقاء النصارى في قلب بلاد الإسلام أربعة عشر قرنًا ونيف بينما زال كل أثر للمسلمين في الأندلس بعد ذهاب دولتهم فيها. وكذلك عند التعرض إلى الديانات الأخرى، فيجب التركيز على الكليات المخالفة للعقل.
- التوسط في تناول مسائل الإعجاز العلمي، فلا يستدل إلا بما دلت البراهين الواضحة على حصول التوافق بشأنه بين الحقيقة العلمية الثابتة والدلالة الظاهرة لنصوص الوحي. ويحسن ألا يكثر عوام الناس من الخوض في هذا الباب ويترك إلى المتخصصين في المجال موضع النقاش.
هذا ما تيسر في هذا المقال من نصيحة في أمر التواصل المتوقع اتساعه بين عموم المسلمين والعالم الخارجي، وفي المقال القادم إن شاء الله نعرض إلى التواصل بين الإسلاميين والقوى الفاعلة في تلك البلاد.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه
[1] يراجع كتاب
آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله، مكتبة ابن تيمية
– القاهرة.