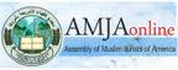كتب لصحيفة الوسط
الحمد لله
ذكرت في المقال السابق أن قنوات كثيرة ستفتح في مجتمع ما بعد الثورة، ومنها قنوات التواصل المباشر بين الإسلاميين والعالم الخارجي، كما يظهر من كلام الوزير الفرنسي وردود الفعل المرحبة من قطاعات واسعة من الإسلاميين. وهذه القنوات لا ينبغي أن تقتصر على الحوار بين الإسلاميين المشتغلين بالسياسة والحكومات الخارجية، بل الأهم هو ما سيكون بينهم كافة وبين
القوى الفاعلة في تلك المجتمعات كرجال الدين والسياسة والفكر والإعلام.
إن الغرب به مدرستان، إحداهما تريد الانفتاح على الإسلاميين بوصفهم قوة صاعدة في العالم الإسلامي ومهما تأخرت أو أخرت فلا بد أن يكون لها نصيب كبير من صياغة مستقبل هذا العالم. المدرسة الأخرى ترى فعل كل ما يمكن من أجل الحيلولة دون وصولهم إلى سدة الحكم، وإن كان الثمن بقاء الأنظمة الفاسدة والفاشلة التي تحكم العالم الإسلامي.
وإننا وإن كنا ندرك ما أدت إليه أحداث الحادي عشر من سبتمبر من إضرار بسمعة الإسلام والإسلاميين، ومن أذى مباشر وغير مباشر لحق طوائف كثيرة منهم وأفرادًا بعينهم، فإن التحليل المستبصر لهذه المرحلة لا ينبغي أن يتجاوز أثر هذه الأحداث في إظهار قوة حجة المدرسة الأولى الداعية إلى الانفتاح على الإسلاميين، أو قل تشجيع التغيير في العالم الإسلامي واحتمال مخاطر هذا التغيير، وذلك لعدة أسباب:
منها اهتراء الأنظمة الحليفة للغرب وتحولها إلى عبء على السياسة الغربية ومصداقيتها؛ ومنها أن التغيرات العالمية في مجالات الاتصال والمواصلات وسائر التكنولوجيات الحديثة جعلت من أفراد منظمين في جماعات سرية خطرًا قد يفوق خطر الدول التي تسمى مارقة؛ ومنها أنه قد ظهر أن شعور شرائح من الشباب المتحمس بأن حكوماته لا تمثله ولا تنطق باسمه سيحملهم على إيصال رسائلهم بأنفسهم وبكل وسيلة ممكنة؛ وأخيرًا، فالحكمة تقتضي أن القطار الذي لا يمكن إيقافه ينبغي أن يسعى إلى تحويل مساره.
إذًا، يقول أصحاب المدرسة الأولى، حتى إن وصل الإسلاميون إلى الحكم بعد سقوط هذه الأنظمة التي لم تعد تصلح يقينًا، دعوهم يحكمون، وعندها سيأتوننا يطلبون الدعم والعلم والتكنولوجيا والعلاج بل والقمح والشعير. إن وصولهم إلى الحكم سيفرض عليهم قدرًا من البراجماتية تغير سلوكهم، ألا ترون براجماتيتهم في تركيا؟
ولكن لماذا يخشى الغرب بفريقيه كل تلك الخشية من الإسلاميين؟
أولاً الغرب لا يخشى الإسلاميين فحسب، بل كل خصم يمكن أن ينافسهم على الريادة، فخشية الولايات المتحدة من صعود الصين السريع لا تخفى على أي مراقب لعلاقات البلدين. ولكن للإسلاميين خصوصيات أخرى تجعلهم أحظى باهتمام الغرب، منها أمور منطقية وأخرى نفسية ومصطنعة، فمن المنطقية الجوار بين الكتلتين البشريتين العظيمتين: مسيحيي أوروبا ومسلمي الشرق الأوسط – كما يحلو لهم أن يسموه – وشمال أفريقيا. ومن النفسية تاريخ الصراع الطويل بين تينك الجماعتين البشريتين. ومن المصطنعة ما ينسجه الغرب من أوهام عن مخاطر تطبيق الشريعة في بلاد الإسلام.
والسؤال هو هل هناك مخاوف يمكننا أن نزيلها لأننا سببنا بعضها أو أسهمنا في صناعتها أو تضخيمها؟
لعل الجواب العاقل هو نعم. ولكن قبل الخوض في تفاصيل ذلك، أنحتاج إلى طمأنتهم؟ الحق أيضًا أن عاقلاً في الدنيا لا يمكن أن يغفل أهمية تألف من يمكنه تألفهم من الناس وتحييد طوائف منهم خارج الصراع بل ومجرد التخفيف من عداوة البعض. من أجل ذلك شرع إعطاء الكفار من سهم المؤلفة قلوبهم وهو قول الجمهور خلافًا للشافعية. والمالكية والحنابلة يرون بقاء هذا التشريع وهو الصواب. ثم ألم يحالف رسول الله خزاعة قبل أن تسلم لما دخل بنو بكر في حلف قريش؟ أولم يقل – صلى الله عليه وسلم – “تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحاً آمِناً وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا من وَرَائِهِمْ فَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ…”[i] وللحديث بقية تذكر قتالاً بعد ذلك معهم، ولكن الشاهد هو أن العلاقة لا يحكمها قانون العداوة المطلقة المانعة من كل تحالف، فهذا القانون يحكم علاقتنا مع الشيطان وحسب!
إن مخاوف الغربيين من الإسلاميين كثيرة، ولكن سأذكر أهمها كنماذج، وأحاول أن أعرض إلى أسبابها، وما يمكن أن نعالجه منها بحوارنا معهم. ولعل من أهمها:
قضية الولاء والبراء وموقف الإسلام المبدئي من الآخر وأثر ذلك على توتير وتأزيم العلاقات بين الناس.
قضية الجهاد وهل سيغزو الإسلاميون جيرانهم متى تمكنوا مرة في كل عام أو مرات، وهل سيكون المسلمون مع المواثيق الدولية ومنظومة التعاون الدولي القائمة أم سينبذون ذلك كله.
قضية الأقليات، وهل سيؤول أمرهم إلى فئات مستضعفة مضطهدة في إطار المجتمع المسلم ذي المرجعية الدينية.
ولعل القارئ يستطيع أن يضيف غير ذلك حسب وجهة نظره، ولكنني عمدًا لم أذكر قضايا المرأة والحدود وغيرها، وذلك لأن هذه من جملة الشبهات، ولكنها ليست مخاوف منطقية، ولا ينبغي أن نتساهل في السماح للآخرين أن يحددوا لنا تشريعاتنا وسائر ممارساتنا، وتدخلهم في هذا هو تدخل فيما لا يعنيهم. أما ما ذكرنا من قضايا، فهي تعنيهم إلى حد ما، وعلينا أن نعالج مخاوفهم إزاءها من غير تفريط في ثوابتنا.
وقبل التفصيل في آحاد تلك المسائل المذكورة أعلاه، فهناك مجموعة مفاهيم عن ذات الحوار مع الآخر ومنطلقات بخصوص الحوار الإسلامي الغربي ينبغي استيعابنا لها.
أما المفاهيم الخاصة بذات الحوار مع الآخر، فهي:
هدف الحوار
إننا قوم معتدون بدينهم واثقون في معتقدهم، وكذلك فنحن راغبون في خير الناس، ولذلك ندعوهم إلى الدخول فيما دخلنا فيه من التسليم لرب العالمين. ولكن هل إقناع الناس بالإسلام وإدخالهم فيه هو الغرض الوحيد من الحوار؟ وهل كل حوار في كل وقت يكون من أجل تلك الغاية النبيلة؟ هل تألف الآخر غاية مقصودة؟ وهل تخفيف عداوته غاية معتبرة؟ الحق أن كل هذه غايات كما سبق في كلامنا عن نصيب المؤلفة قلوبهم. وكذلك، فليست الاستفادة من الآخر وتجربته خارجة عن أهداف حوارنا معه، فهذا رسول الله يقول لقد هَمَمْت أن أنهَى عن الغِيلَة فنَظَرت في الرُومِ وفَارِس فإذا هُم يُغِيلون أولادَهُم فلا يَضُرُّ أولادَهُم ذلك شَيئاً ” [مسلم: 4 : 478. و الغيلة: وطء الحامل أو المرضع]
مستويات الحوار
اللفظ والمفهوم والسياق هي مستويات الحوار الثلاثة التي ينبغي أن نراعيها، فدقة اللفظ ووضوح المفهوم ووضع كل ذلك في السياق المناسب كلها أمور ينبغي أن تلقى عناية المحاور في فهمه للآخر وإفهامه له. مثلا كلمة جهاد تحتاج إلى بيان مفهومها، ولكن حتى مع بيانه، قد يكون استعمالها مستحسنًا في بعض السياقات دون بعض، وكذلك فإن بيان السياق أو بساط الحال المصاحب للفتوحات الإسلامية مهم ولا يغني عنه فهم معنى الكلمة اللغوي، بل سيساعد في إدراك حقيقتها الشرعية.
أنواع الحوار
للحوار أنواع، منها المثاقفة والمناظرة والمجادلة والمنازعة، ومنها على المعنى الأعم التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من تقارب وجداني وتلاقح فكري. ولكل من هذه الأنواع لغة تناسبه، ووضوح نوع الحوار لكلا الطرفين مهم لإنجاحه، فإن الكلام مع من يريد المثاقفة أو المناظرة بلغة المجادل المنازع لمما يفضي إلى فشل الحوار وضياع مقصوده، وليس العكس بأقل ضررًا.
في المقال القادم نعرض – إن شاء الله – إلى منطلقات مهمة بخصوص حوار الإسلاميين مع الآخرين عمومًا والغرب خصوصًا.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه